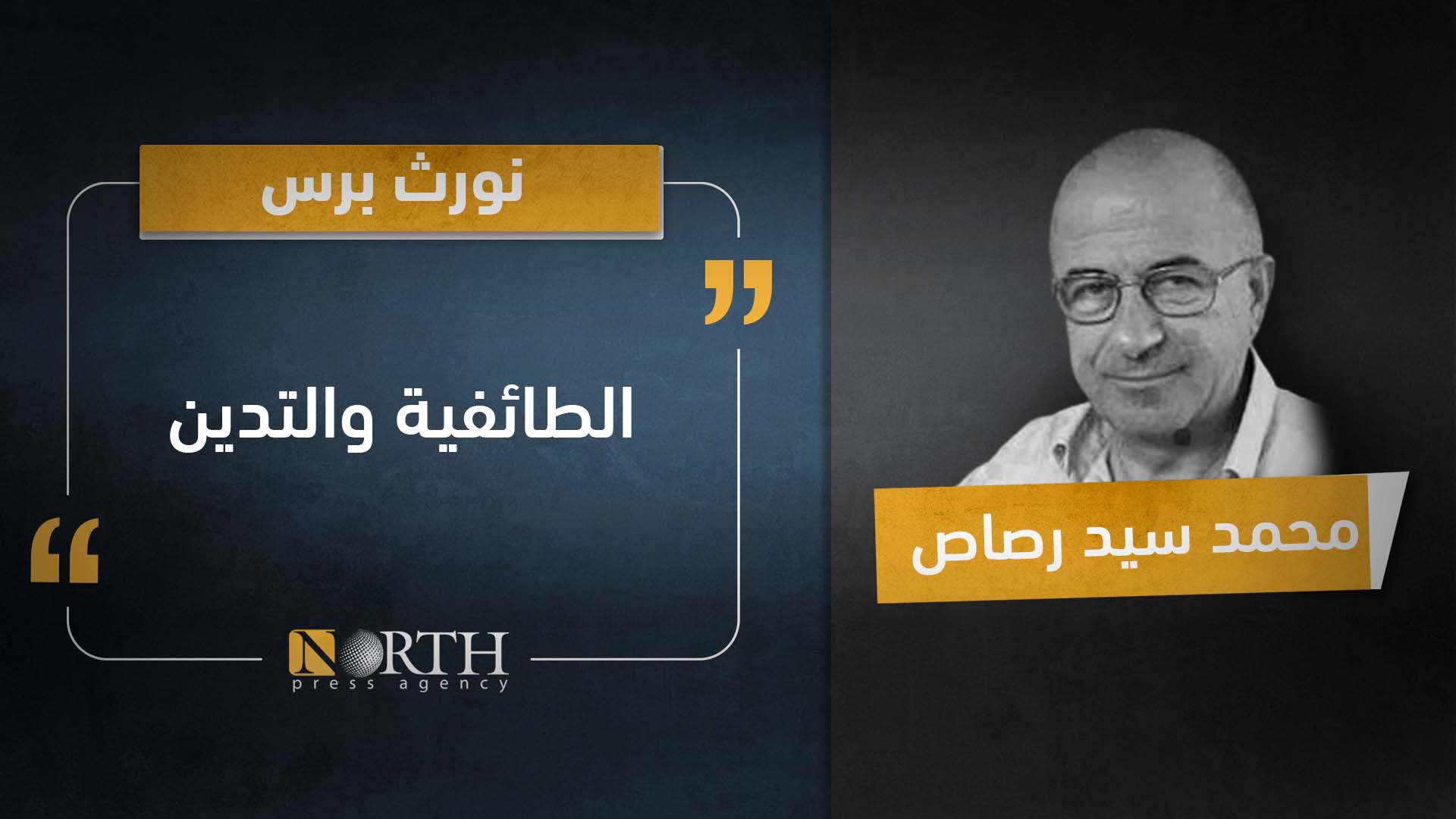من يقارن بين الوزير اللبناني جبران باسيل وزعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني يلمس أن إحساس الأول بطائفته أعلى من إحساس الثاني بطائفته رغم شدته. الكثير من أفراد التيار العوني الذي يتزعمه “باسيل” يعتبرون أنفسهم علمانيين وغير متدينين ولكنهم يرون في التيار الذي فاز بأكثرية أصوات المسيحيين في ثلاث انتخابات برلمانية في الأعوام 2005 و2009 و2018 وسيلة لتجاوز “الإحباط المسيحي” الذي أصيب به الكثير من المسيحيين بعد اتفاق الطائف عام 1989، ووسيلة لتحصيل المسيحيين حصتهم في الدولة اللبنانية ولو قاد هذا إلى مظاهر ملفتة مثل إعاقة العونيين في مجلس الوزراء للمصادقة على تعيين حراس غابات نجحوا في مسابقة نظامية رسمية بحجة أنه لا توجد مناصفة بين المسيحيين والمسلمين في تلك المسابقة.
كان العونيون عام 1989 قد ضربوا البطريرك صفير بتحريض من الجنرال ميشال عون رئيس الحكومة العسكرية بسبب قبول صفير باتفاق الطائف، كما أنهم الآن يختلفون مع البطريرك الراعي حول مشروعه لـ”حياد لبنان عن الصراعات الإقليمية “، ما دام حليف العونيين (حزب الله) يرى نفسه المستهدف من طرح البطريرك. وأغلب العونيين ليسوا متدينين وهم يمثلون الشريحة الغنية أو أعلى الفئة الوسطى بين مسيحيي لبنان.
هنا، يمكن أن نجد حالة جبران باسيل عند محمد علي جناح مؤسس دولة باكستان عام 1947 عندما نادى منذ الثلاثينيات بدولة منفصلة لمسلمي الهند وسط محيط من الأكثرية الهندوسية، فهو بدوره كان علمانياً وغير متدين، ولكنه أحس بطائفية شديدة ضد طغيان الأكثرية الهندوسية العددي في دولة الهند القريبة الاستقلال عن بريطانيا، ولكن تلك الطائفية لم تدفع زعيم “الرابطة الاسلامية” إلى أكثر من جعل باكستان “دولة لمسلمي الهند” وليس “دولة إسلامية” كما نادى أبو الأعلى المودودي زعيم “الجماعة الاسلامية”، تلك الدولة التي أسماها الهندوس بـ”إسرائيل المسلمين” والتي سبقت الدولة العبرية في الولادة بتسعة أشهر. وفعلاً، هنا، يمكن المقارنة بين جناح وكل من مؤسس الحركة الصهيونية تيودور هرتزل ومؤسس دولة إسرائيل دافيد بن غوريون حيث كانت طائفيتهما اليهودية المجسدة في صهيونيتهما مترافقة عندهما مع اللاتدين والعداء للمتدينين اليهود (الحريديم)، إن لم تكن عند هرتزل تترافق الطائفية مع الإلحاد.
وعلى هذا الصعيد، يمكن لدراسة حالة هرتزل أن تكون نموذجية، من حيث أن وصوله للصهيونية أتى كرد فعل على قضية دريفوس في فرنسا التي اتهم فيها ضابط يهودي فرنسي بالتجسس لصالح الألمان، حيث كانت مظاهر العداء لليهود التي استيقظت آنذاك في تلك القضية التي ثبت زيفها كافية لإقناع المراسل الصحفي النمساوي بأن لا مكان لليهود في المجتمعات الأوروبية وأنه يجب تأسيس “الدولة اليهودية” التي كانت عنوان كتابه عام 1896 بعد سنتين من تلك المشاهد الباريسية وقبل سنة من عقد المؤتمر التأسيسي للحركة الصهيونية في سويسرا. لم تقد الطائفية اليهودية المجسدة في الصهيونية، التي أتت كرد فعل امتلك نفوس وعقول الكثير من يهود أوروبا بين باريس وموسكو، على اضطهاد اليهود السياسي والثقافي والاجتماعي، إلى أكثر من إحساسهم بأنهم يجب أن يبحثوا عن مكان آخر للعيش يمكن أن يشكل إطاراً لدولة لليهود.
في الصهيونية الهرتزلية هناك وعي طائفي للذات، هو دفاعي أمام اضطهاد هجومي من (الآخر)، وليس وعياً للذات الطائفية يمكن أن يمتلك ابن أكثرية مهيمنة ثقافياً وذات أكثرية اجتماعية كما نجد عند الإسلامي المصري أو السوداني أو التونسي أو الجزائري أو المغربي، حيث لا يطلب الإسلامي هناك بحقوق “طائفته” بل بتطبيق ما يرى أنه البرنامج السياسي الإسلامي، وهو يعتبر نفسه متمايزاً عن المتدين المسلم، من حيث أنه يرى الإسلام ليس فقط عبادات وطقوس ومعاملات، بل أيضاً وأولاً “دين ودولة”.
الإسلامي، في نسختيه السنية والشيعية، هو طائفي هجومي من حيث إحساسه السياسي بطائفته، ومن حيث موقفه من الآخر، ويمكن لنماذج ملتحقة بالإسلاميين، مثل أحمد الجلبي في العراق أو رياض الترك في سوريا، أن تكون طائفية أيضاً حتى ولو كانت علمانية مثل الجلبي أو ليبرالي جديد ترك الشيوعية والماركسية مثل الترك.
هنا، عند الأقليات الدينية والطائفية وفي مجتمع يعاني من اللااندماج ، يمكن للطائفية عند تلك الأقليات أن تكون مثل جبران باسيل، أي طائفية تبحث عن حصة في دولة مكونات ومحاصصة، أو طائفية سلبية دفاعية خائفة من سيطرة الأكثرية على السلطة، والخوف هنا هو الذي يمكن أن يصل إلى حالة مرضية تشبه حالة الخوف المرضي، أي الفوبيا، ويكون عاملاً رئيساً في تشكيل الوعي الطائفي عند الحالات المذكورة، حيث عبر هذه الفوبيا يتشكل وعي الذات ووعي الآخر، وهذه الفوبيا يمكن أن تشكل ثقافة ورؤية للتاريخ، كما في رؤى نجدها الآن في سوريا تحاول أن تبخس التاريخ الإسلامي وتعلي تاريخ سوريا ما قبل الإسلام.
على صعيد آخر، يمكن هنا أن تكون حالة سنة العراق العرب بعد سقوط صدام حسين عام 2003 نموذجية، من حيث حالة طائفة هي أقلية عددية ولكنها كانت تحكم العراق منذ تأسيس دولته الحديثة عام 1921، رأت نفسها بعد صدام في حالة تجريد كبير من السلطة لصالح ثنائية شيعية-كردية، ما دفعها للتعبير عن ذاتها الطائفية عبر هجومية مضادة مثلتها “القاعدة” بين الأعوام 2004-2006 و”دولة العراق الإسلامية” بين الأعوام 2006-2013 ثم “داعش” التي تأسست في الذكرى العاشرة لسقوط صدام حسين في التاسع من نيسان 2013، وقد مثلت هذه الأشكال السياسية الثلاث أغلبية اجتماعية داخل سنة العراق العرب، ولو أن الأمر اختلف بعد اضمحلال (داعش) بدءاً من عام 2017.
الكثير من قادة “القاعدة” و”داعش” في العراق كانوا قوميين عرب بعثيين ومعظمهم غير متدينون، ويمكن لمؤسس “داعش” الفعلي، أي سمير الخليفاوي (حجي بكر)، أن يلخص حالة الكثير من سنة العراق العرب، حيث كان عقيداً في الجيش العراقي ومسؤولاً أمنياً في قاعدة الحبانية الجوية، وبعثياً غير متدين ويشرب الخمر، ولكنه بعد عام 2003 مع حل الجيش العراقي من قبل الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر اشتغل سائق تاكسي ثم التحق بـ”القاعدة” وكان له دور أساسي في “دولة العراق الإسلامية” ثم كان له الدور الرئيس في تنصيب أبو بكر البغدادي أميراً لتلك الدولة بعد مقتل أبو عمر البغدادي في نيسان 2010 وهو المؤسس الفعلي لـ”داعش” ومهندس امتدادها في سوريا قبل أن يقتل في بلدة تل رفعت في كانون الثاني عام 2014، وكان مفاجئاً أن لا يوجد في البيت السري الذي قتل فيه، حسب تحقيق لمجلة “دير شبيغل الألمانية” نشر في نيسان2015، سجادة صلاة ولا نسخة من القرآن ولا نسخة (كاملة أو موسعة أو مصغرة) من “صحيح البخاري”.