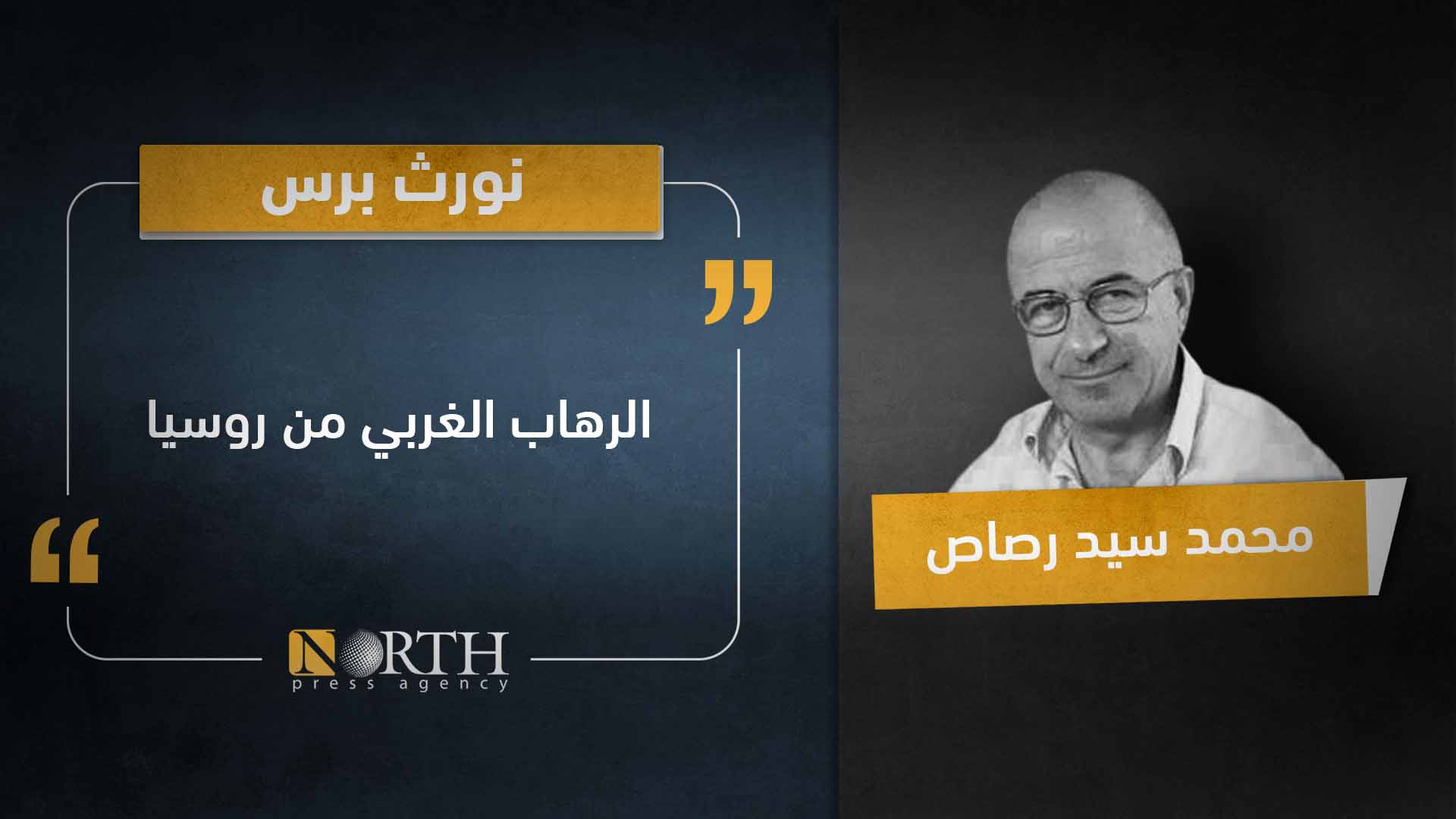في مؤتمر فيينا عام 1815، الذي انعقد عقب هزيمة فرنسا في معركة واترلو، تم تسمية المنتصرين على نابليون بونابرت بالأربعة الكبار، وهم بريطانية وروسيا والنمسا وبروسيا. كان أول من شعر بالخطر الروسي هم البريطانيون، وقد بان هذا من أعمال المؤتمر حيث لم تتجه لندن إلى إذلال فرنسا، كما أن سياستها كانت تشجيع النمسا على التوسع شرقاً وجنوباً نحو البلقان، من أجل أن تصطدم مع روسيا التي كانت منذ ذلك الوقت قد أعلنت نفسها زعيمة للسلاف، وعندما حصلت الوحدة الألمانية في عام 1871 حسب البريطانيون بأن برلين ستكون كابحاً لغريمتهم القديمة، أي فرنسا، وستكون كذلك لغريمتهم الجديدة، أي روسيا، ولم تتجه لندن للتحالف مع الفرنسيين والروس إلا بعد أن اتجه الألمان إلى التخلي عن سياسة السلام التي انتهجها بسمارك مع البريطانيين، وربما كانت إشارة الصدام هي زيارة القيصر الألماني لدمشق عام 1898 وإنشائه تحالفاً مع العثمانيين، وهو ما جعل البريطانيين في اتجاه نحو قتل “الرجل المريض” العثماني الذي حموه طوال القرن التاسع عشر من نابليون بونابرت ومحمد علي باشا والقيصر الروسي.
هنا، لم يقتصر الرهاب من روسيا على البريطانيين، بل كان هناك اجتماع لليمين واليسار الأوروبيين ضد روسيا في القرن التاسع عشر.
على اليمين نجد مثالاً مكتوباً في كتاب نشر بباريس عام 1843 بعنوان: “روسيا عام 1839” لأحد الأرستقراطيين الفرنسيين بعد زيارة استغرقت خمسة أشهر لروسيا، هو (المركيز استولف دوكوستين)، وهو كاثوليكي متدين، وكان أبوه وجده قد أعدما بالمقصلة في فترة سيطرة اليعاقبة بعامي 1793 و1794 عقب الثورة الفرنسية. في هذا الصدد، يلفت النظر أنه لم يكن هناك عند دوكوستين أي من مشاعر الامتنان للروس التي شعرها الكثير من الأرستقراطيين الفرنسيين لما شاركت الجيوش الروسية في هزيمة وريث الثورة الفرنسية نابليون بونابرت. هو ذهب لهناك بدافع الفضول لمجهول، وحاول أن يكون الرائي المحايد ولكنه لم يستطع ذلك أثناء الرحلة وأثناء الكتابة بعد العودة. في النص المكتوب يشبه روسيا بسجن يسوده “صمت الخوف” وأن القيصر هو “الذي يتنبأ ويقيس وينظم ويوزع كل ما هو ضروري ومسموح به لذلك ليس من المباح لأي مخلوق بأن يتنفس أو يتألم أو يحب خارج الأطر المرسومة سلفاً من جانب الحكمة العليا” وهو يقول بأن مبررات الحاكم الأتوقراطي القيصري تتمثل في أن “المركزة الصارمة ضرورية لحكومة امبراطورية هائلة الاتساع مثل روسيا”. لا تبهر دوكوستين مظاهر التغريب الروسية بل يقول بأنها “المحاكاة المعادية” و”التقليد عندما يكون معادياً” وأن بطرس الأكبر يمم وجهه للغرب “ليسرق ثمار المدنية” ولكن من دون أن “يغرس بذور هذه المدنية” وهو يرى أن التغريب مجرد “طلاء” بينما في العمق روسيا هي “بربرية حديثة” ولكن مع “تقنية الغرب وعلومه” ومن “دون تغيير ذاتها”. دوكوستين يقول بأن روسيا لها طموح “الأمة الغازية” وأنها لا تفكر شرقاً ولا جنوباً بل غرباً حيث أنها “ترى في أوروبا فريسة ستسلم لها عاجلاً أوآجلاً” (يمكن إيجاد ملخص تفصيلي عن كتاب دوكوستين في “روسيا بين 1815 – 1991” لجورج سكولوف، ج1، ق1، وزارة الثقافة، دمشق 1999، ص 18-41).
على اليسار في الرهاب من روسيا نجد كارل ماركس، حيث يقول فرانز ميهرنغ في كتابه “كارل ماركس” بأن “الحرب ضد روسيا كانت المحور الذي تحركت عليه (نيو راينيخه تزايتونغ) في السياسة الخارجية” (دار الطليعة، بيروت 1972، ص 133) وهي الجريدة التي رأس تحريرها ماركس عند تأسيسها في حزيران 1848. لم يكن موقف ماركس مبنياً على اعتبارات أخرى سوى الخوف من أن مد الثورات الأوروبية الذي عم الكثير من البلدان عقب ثورة شباط 1848 الفرنسية سيكون القيصر الروسي هو رأس حربة الثورات المضادة لها، وهو ما تحقق في العام التالي لما جاء الجيش الروسي وسحق الثورة المجرية لصالح العرش النمساوي.
ولكن عملياً كان هناك رهاب من روسيا جمع الأرستقراطي الفرنسي وكارل ماركس.
هنا، كان ما جمع دوكوستين وماركس هو القيصر الروسي نيقولا الأول 1825-1855 الذي يمكن أن نلخص فترة حكمه بعبارته: “الثورة على أبواب روسيا، ولكني أقسم أنها لن تدخل إليها ما بقيت حياً”، وهو الذي واجه بعد قليل من توليه الحكم ثورة “الحركة الديسمبرية” في الشهر الأخير من عام 1825 لما حاول ضباط في الجيش الثورة ضده، وهم الذين تأثروا بأفكار الثورة الفرنسية لما دخلوا باريس قبل عشرة أعوام ضمن قوام الجيوش التي هزمت وريث الثورة نابليون بونابرت، حيث بعدها تصرف نيقولا الأول باستراتيجية منع الثورة في روسيا، ليس فقط عبر القبضة الحديدية في الداخل، بل وبالذهاب نحو الخارج لقتلها. كان المثال المجري بذهن القيصر الروسي في عام 1853 عندما ظن بأنه سيكون صك مرور له عند الحكام الغربيين من أجل تحقيق حلم روسي قديم بالسيطرة على مضيقي البوسفور والدردنيل، ولكنه فوجئ وصعق عندما وقف الأوروبيون الغربيون كلهم ضده ومع العثمانيين، بما فيهم العرش النمساوي الذي أنقذه قبل أربع سنوات والذي كان لا يريد للروس أن ينافسوه في البلقان عبر “الرابطة السلافية” عند الصرب والبلغار أو عبر “الرباط الأرثودكسي” لدى اليونانيين المستقلين حديثاً، وكانت لندن أولهم وهي التي لا تريد للروس أن يهزوا سيطرتها على البحر المتوسط، ومعها لوي بونابرت (نابليون الثالث) الذي تعلم من تجربة النهاية المرة لعمه الذي مات منفياً في جزيرة سانت هيلانة بعد مواجهة الانكليز. أثار نيقولا الأول رهاباً غربياً جماعياً وهو ما قاد إلى تكاتف الجميع ضده حتى هزموه في حرب القرم، وقد مات كمداً من القهر بمرض مفاجئ قبل توقيع صك الهزيمة الروسية في معاهدة باريس في آذار 1856.
الآن، وفي هذه الأيام نشهد النزلة الثالثة من الرهاب الغربي من روسيا، وكانت الثانية في عام 1946 لما تحدث وينستون تشرشل عن “ستار حديدي يقسم أوروبا يمتد بين بحري البلطيق والأدرياتيك” أقامه جوزيف ستالين وهو ما جعل الأوروبيين الغربيين يرتمون مذعورين في حضن واشنطن التي بدأت بشن الحرب الباردة بالعام التالي ضد السوفيات.
في المرة الأولى أثار نيقولا الأول الهلع عند الغربيين وفوجئ هو كما فوجئوا هم، وفي الثانية أحس الغربيون برهاب من الروس الذين كبرت قوتهم كثيراً بعد مساهمة الاتحاد السوفياتي الأكبر في هزيمة هتلر، وفي الثالثة أحس الغربيون بالرهاب الخائف من الروس عندما قام الأخيرون بتلك الهبة الهجومية على الغرب الأميركي- الأوروبي من خلال غزو أوكرانية بعد أن استضعفهم الغربيون كثيراً إثر انهيار وتفكك الاتحاد السوفياتي وحاصروهم من خلال خطط تمدد الحلف الأطلسي- الناتو شرقاً التي كادت أن تصل لمحاولة خنق الاتحاد الروسي وتفكيكه من خلال ضم أوكرانية للناتو.