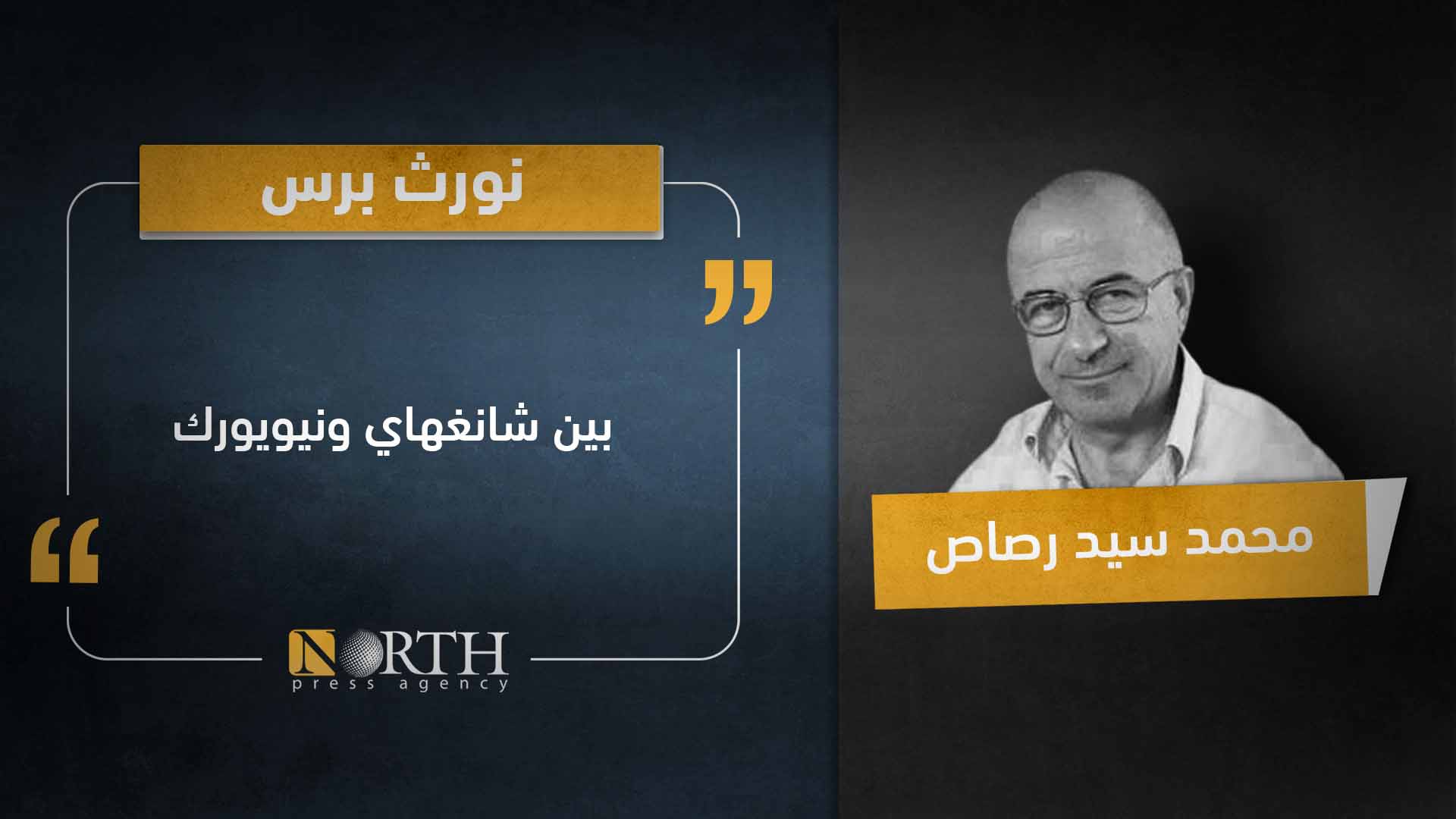في عام 2018، قامت الإدارة الأميركية بإدراج الصين وروسيا كخطرين على الأمن القومي الأميركي، في خطوة غير مسبوقة منذ عام 1971عندما اتجهت إدارة نيكسون-كيسنجر نحو التقارب مع الصين مستغلة الخلاف الصيني-السوفياتي. وفي الثامن من أيار/ مايو 2018 قامت واشنطن بسحب توقيعها من الاتفاق النووي مع طهران.
خلال الأربع سنوات الفائتة، هناك كتلة تضم الصين وروسيا وايران هي الآن في مرحلة التبلور، وتكاد أن تتشكل عبر خطوات عملية، إحداها ما تم قبل أيام قليلة من مناورات بحرية مشتركة لهذه الدول الثلاث في شمال المحيط الهندي.
ازداد التقارب بينها وتقاطع بسبب سياسة المجابهة التي تنتهجها واشنطن مع بكين منذ عام 2011 مع الإعلان عن السياسة الأميركية “نحو الانزياح والتركيز على الشرق الأقصى” لمجابهة الصين التي أصبحت بنظر الأميركيين التهديد الأكبر لوضعية القطب الأميركي الواحد للعالم مع وصولها للمرتبة الاقتصادية الثانية في العالم عام 2010، وبسبب التوتر الأميركي- الروسي الناتج عن الأزمة الأوكرانية وعن القلق الأميركي من سياسة فلاديمير بوتين نحو محاولة السيطرة الروسية على المحيط السوفياتي السابق، وبسبب الرفض الأميركي، المعلن بقوة من قبل إدارة دونالد ترامب والأقل قوة عند إدارة جو بايدن، للتمدد الايراني في منطقة الشرق الأوسط، وهو تمدد كان هناك موافقة ضمنية عليه من إدارة باراك أوباما أو غض بصر عنه مادام قد سكت عنه الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، حيث كان هذا هو اعتراض ترامب الأساسي على الاتفاق وهو مطلب بايدن الرئيسي الآن في المفاوضات الجارية حالياً في فيينا لإحياء الاتفاق النووي من حيث أن يكون هناك ترافق في الاتفاق الجديد بين الموضوع النووي وبين موضوع السياسة الإقليمية الإيرانية.
هذه الكتلة، التي تتبلور الآن، تجتمع دولها الثلاث على مصلحة مشتركة في تشكيل قوة تستطيع موازنة القوة الأميركية، التي هي الآن القوة الوحيدة التي يمكن القول بأنها قوة عالمية اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً وثقافياً وكنمط حياة، فيما الصين قوة شبه عالمية، اقتصادياً على الأقل ولكنها ليست كذلك سياسياً وعسكرياً، فيما روسيا قوة كبرى ذات تأثير في محيط جغرافي محدد هو المحيط السوفياتي السابق ولها تأثير في الشرق الأوسط من خلال وجودها العسكري في سوريا وتملك سلاحاً اقتصادياً هو الغاز الذي تورده لدول الاتحاد الأوروبي بنسبة الثلث من احتياجاته، بينما إيران قوة اقليمية عظمى في الشرق الأوسط من خلال تمدداتها الداخلية في دول العراق ولبنان واليمن وتأثيراتها في سوريا وفلسطين وأفغانستان.
في هذه الكتلة، الصين هي الأقوى، بما تملكه من اقتصاد، وبما تقدمه من نمط نظام يقوم على الوحدانية السياسية المتمثلة في سيطرة حزب واحد مع تعددية اقتصادية يكون فيها قطاع الدولة في الاقتصاد هو الأقوى أو هو المدير لاقتصاد السوق بمكونيه من رأس المال المحلي والأجنبي، مع بعد ثالث لهذا النظام يتمثل في مزج الأيديولوجية الماركسية مع القومية الصينية والثقافة المحلية.
النظام الصيني السياسي الراهن هو وريث شيوعية صينية، بدأت مع ماوتسي تونغ منذ توليه زعامة الحزب عام 1935وتبلورت مع وصول الشيوعيين للسلطة بعام 1949، ترى أن الطريق الماركسي هو طريق للتحرر الوطني من السيطرة الأجنبية وطريقاً للنهوض القومي، وقد تابع دينغ سياو بينغ بعد وفاة ماو في عام 1976 هذا الطريق ولكن من أجل التحديث الاقتصادي وهو الذي وضع اللبنة الأولى للعملقة الاقتصادية التي أوصلت الصين إلى الرقم الاقتصادي الثاني في العالم بعام2010.
نظام بوتين يشبه النظام الصيني، من حيث وجود سيطرة ولكن لفرد بدل حزب مع أيديولوجية قومية روسية ممزوجة باتجاه ثقافي ديني أرثودكسي مع تعددية اقتصادية بالترافق مع قطاع دولة في الاقتصاد بالغ القوة وخاصة في النواحي الاقتصادية الاستراتيجية كما في قطاع التكنولوجيا العالية أو قطاع التصنيع الحربي، مع توق روسي بالغ الشدة نحو استعادة مكانة موسكو العالمية السابقة.
في إيران، هناك حكم لرجل واحد هو “المرشد” علي الخامنئي مع قطاع دولة في الاقتصاد بالغ القوة بالتوازي مع اقتصاد سوق في “البازار”، بالترافق مع أيديولوجية دينية شيعية إسلامية ممزوجة بالقومية الفارسية، مع توق امتدادي لفرض نفوذ إقليمي وخاصة في الجوار الغربي للجغرافية الإيرانية.
هناك دول تتلاقى مع هذه الكتلة التي لم تتشكل بعد، مثل بيلاروسيا وطاجيكستان وسوريا وفنزويلا، وهناك دول ترى مصالح ظرفية آنية في التلاقي معها، مثل ميانمار وباكستان وتركية وإثيوبيا، فيما هناك حركات وأحزاب، مثل الحوثيون في اليمن وحزب الله في لبنان وأحزاب شيعية عراقية، لها تأثرات سياسية أيديولوجية بطهران وهو ما يجعلها تمشي مع إيران في مجابهة واشنطن، وهي ترى تلاقياً وتقاطعاً مع حالة المجابهة الصينية – الروسية للأميركيين. أيضاً، هناك الكثير من الحركات اليسارية، وأفراد يساريون، يرون أنفسهم الآن ولدوافع مختلفة مع هذه الكتلة ضد واشنطن، ولو أن هناك شيوعيون وماركسيون لا يجدون أنفسهم مع هذه الكتلة وفي الوقت نفسه هم ضد واشنطن. وهناك حركات، مثل (الإخوان المسلمين)، تجد نفسها الآن حائرة بين الجهتين، بعد أن تركت واشنطن التحالف معها.
حتى الآن لا يمكن الحديث عن أيديولوجية سياسية، لها رؤية فلسفية للعالم مع فكر سياسي ورؤية اقتصادية- اجتماعية- ثقافية، في مواجهة الولايات المتحدة كما كان عند الاتحاد السوفياتي بزمن الحرب الباردة، بل هناك نزعة عداء للأحادية القطبية الأميركية للعالم عند الصين وروسيا وإيران مع محاولة لخلخلة هذه الأحادية من خلال الاتجاه نحو بلورة كتلة مشتركة، فيما ترى الدول والحركات والأحزاب المذكورة أن هناك تلاقيات مع هذا الاتجاه انطلاقاً إما من مصالح أومن أيديولوجيات ممزوجة بمصالح. لا يقود هذا إلى أيديولوجية سياسية مشتركة بل إلى جبهة عالمية ضد الأميركان.
بالمحصلة، فكما أن العاصمة الصينية بكين هي في موقع صدارة المجابهة العالمية للعاصمة الأميركية واشنطن من الناحية السياسية، فإن العاصمة الاقتصادية والثقافية للصين، أي شنغهاي، تتبلور الآن كنموذج لنمط حياة ولثقافة في مواجهة نمط الحياة والثقافة الأميركيتين التي تعطيها نيويورك، وهذا، وذاك، سيطبع القرن الواحد والعشرين بطابعه، وسيؤثر على مختلف دول العالم، كما جرى كتنافس سياسي – اقتصادي- اجتماعي- ثقافي بين لندن وباريس بين عامي 1756 و1815حتى هزيمة نابليون بونابرت في معركة واترلو وكما جرى بين الأميركان والسوفيات بين عامي 1947 و1989 بالحرب الباردة.