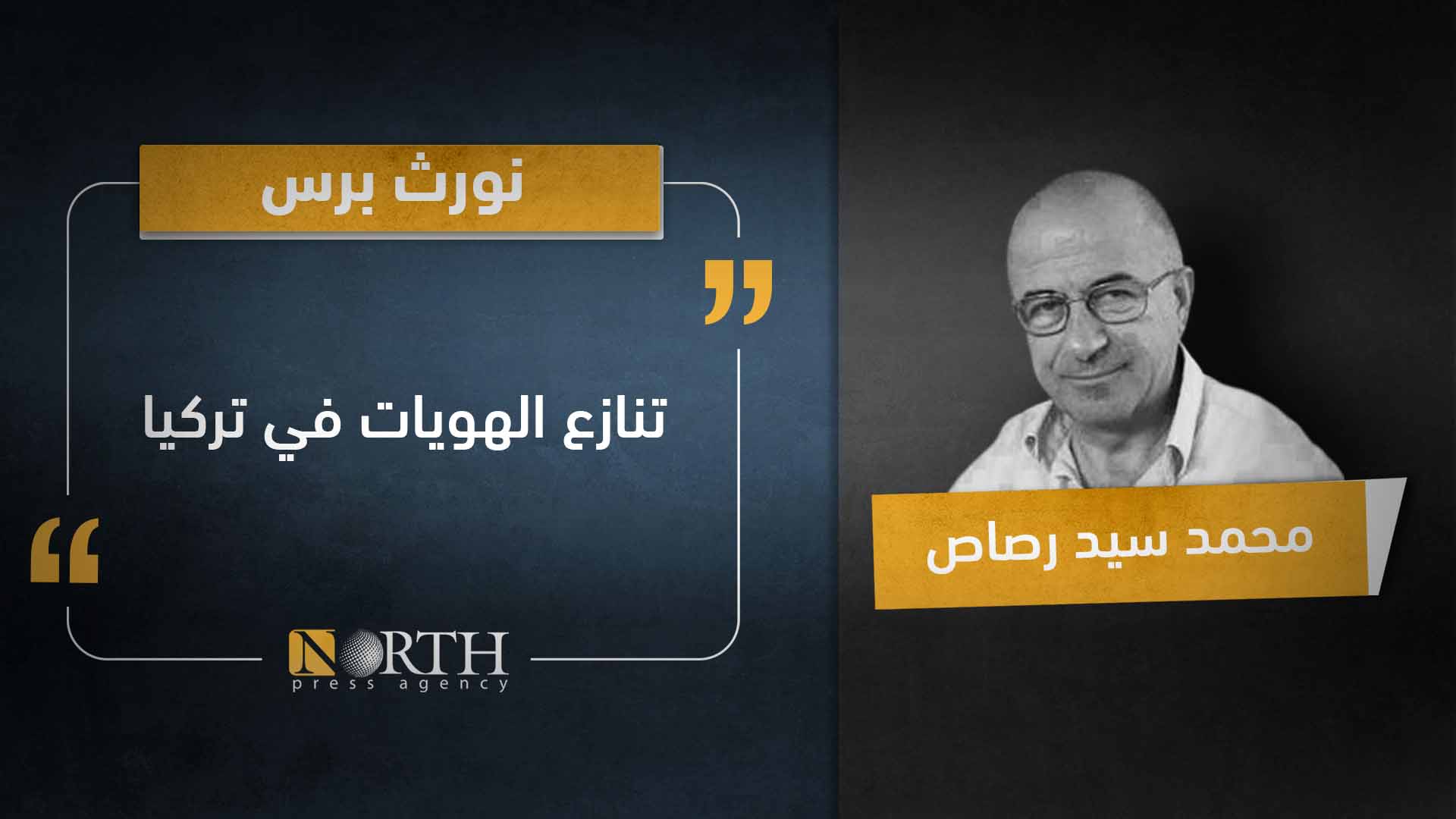هناك أربعة أحزاب رئيسية في البرلمان التركي لعام 2018، كل واحد منها يقدم مشروعاً مختلفاً عن الآخر لهوية البلد. هذه الأحزاب هي التالية:
- حزب العدالة والتنمية (له 42%من الأصوات): يقدم مشروعاً إسلامياً ممزوجاً بنزعة قومية تركية، يرى من خلاله أن الهوية الحضارية التركية هي في المحيط الاسلامي.
- حزب الحركة القومية (11%): يقدم مشروعاً قومياً تركياً طورانياً، ممزوجاً بشيء من الإسلام، يعتبر فيه أن المحيط الطبيعي لتركيا هو محيط تركي قومي- ثقافي يمتد من تركستان الصينية إلى بحر إيجة.
- حزب الشعب الجمهوري (22%): يتبنى القومية التركية بطبعتها الأتاتوركية العلمانية التي ولدت مع الدولة التركية التي انبثقت عن معاهدة لوزان عام1923 والتي عنده انحصرت بنطاقها الجغرافي، وهو يرى أن المحيط الحضاري التركي في نطاق الغرب الأوروبي.
4- حزب الشعوب الديمقراطي (11%): يرى أن تركية دولة متعددة القوميات والشعوب، ويخالف الأحزاب الثلاثة السابقة في أن الهوية القومية للدولة التركية منجزة ومنتهية، وهو يعتبر أن بروز وانفجار المسألة الكردية التركية منذ عام 1984 يدل على أن الإصرار على مسألة الهوية القومية التركية المنجزة هو الذي فجر الوضع الداخلي التركي في الأربعة عقود الماضية من الزمن، وهو يرى بأن الحل في مشروع “الأمة الديمقراطية” التي تشكل وعاءاً وخيمة لقوميات وشعوب وهويات متعددة تعيش في النطاق الجغرافي التركي الحالي.
يمكن القول من خلال هذه المشاريع الثلاثة المخالفة لمسار الدولة التركية ما بعد عام 1923 بأن الحل الأتاتوركي قد فشل بعد قرن كامل من التجريب، وأن فشله هو الذي يشكل التربة الملائمة لنمو وبروز هذه المشاريع الثلاثة التي تشكل غالبية مجتمعية تركية.
المسألة الثانية تدل على أنه لا يوجد في تركيا وعاء هوياتي جامع للأتراك، وأن تركية، إذا أخذنا مصطلح ستالين في دراسته عن مسألة القوميات عام 1913، هي أمة “غير مكتملة التكوين”، أو بالأصح الأتراك الآن يبحثون عن هوية جامعة لهم ما داموا حتى هذه اللحظة لم يتفقوا بعد على هوية البلد.
المسألة الثالثة أن هناك تناقضات بين المشاريع الأربعة يجعلها لا تتلاقى في نقطة مشتركة، ربما باستثناء التلاقي الذي وجدناه بالسنوات الأخيرة بين الإسلاميين والطورانيين في تحالف سياسي حاكم، فيما التباعد جبهي أيديولوجي بين الأتاتوركيين والإسلاميين، ولا تقود النزعة القومية المشتركة بين الأتاتوركيين والطورانيين إلى تلاقيات مادام هناك خلاف بينهما حول النطاق الجغرافي للقومية التركية ومادام الطورانيون لا يوافقون على النزعة العلمانية الأتاتوركية، كما أن مشروع “الأمة الديمقراطية” يتناقض مع الإسلاميين والطورانيين والأتاتوركيين. المسألة الرابعة أن التناقضات بين المشاريع الأربعة لا تقتصر على الرؤية الخاصة بالبيت الداخلي التركي بل كل مشروع منها يحوي رؤية مختلفة للعلاقات الدولية وللمحيط الجغرافي المجاور للدولة التركية القائمة.
من جهة أخرى، كان أحد تلك المشاريع يأخذ دفعاً من بيئة متحركة للعلاقات الدولية، فالجنين الإسلامي الذي فوجئ الأتاتوركيين بولادته في انتخابات 1950، أي الحزب الديمقراطي بقيادة عدنان مندريس، ثم كرر فوزه في برلماني 1954 و1957، قد لاقت أشرعته دفعاً من الرياح الغربية في الحرب الباردة ضد السوفيات من خلال انضمام تركية لحلف الأطلسي في عام 1952، وهو درس أدركه الأتاتوركيين بعد انقلابهم العسكري على مندريس عام 1960 حيث كانت نزعتهم الأطلسية واضحة حتى التسعينيات وحتى انقلابهم في 1997 ضد رئيس الوزراء نجم الدين أرباكان الإسلامي النزعة كان مدعوماً من واشنطن. بدورهم، انتعش الطورانيون مع تفكك الاتحاد السوفياتي عام 1991 وحتى الرئيس التركي توركوت أو زال قبيل قليل من وفاته قال بأن هناك “عالم تركي يمتد من تركستان الصينية إلى بحر إيجة”، ويبدو أن الدوائر الأميركية بالتسعينيات قد فكرت (ولكن لم تكمل إلى التنفيذ العملي) في دعم جهد تركي، ضد موسكو وطهران، تكون فيه أنقرة في جامعة تركية سياسية – اقتصادية- ثقافية- لغوية تضم معها أذربيجان وتركمانستان وكازاكستان وأوزبكستان وقرغيزيا مثلما كانت مصر في الجامعة العربية منذ الأربعينيات بتشجيع من لندن وينستون تشرشل وأنطوني إيدن. في حالة ثالثة، انتعشت ظاهرة رجب طيب أردوغان إثر 11 سبتمبر 2001 لما اعتمدته واشنطن حتى عام 2013 “كنموذج إسلامي أميركي” يدعم عبره الأميركان تلاميذ حسن البنا في وجه أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، وقد مشى هذا التوجه الأميركي ولاقى فرصة كبرى مع ما سمي بـ”الربيع العربي”، وفي خريف 2011 أثناء زيارة أردوغان لمصر ما بعد سقوط حسني مبارك وبروز قوة الإسلاميين تصرف رئيس الوزراء التركي وكأنه طبعة ثانية من السلطان سليم بعد هزيمته للمماليك في مصر عام 1517، وكانت واشنطن تدعمه يومذاك في إيصال الإسلاميين للسلطة في دمشق. الآن، يعيش أردوغان ومنذ عام 2016 على التناقضات الأميركية- الروسية ويلعب عليها.
هنا، ليس بعيد الاحتمال، أو ضعيفة، أن ينفجر الوضع الداخلي التركي وتفتح جبهة مواجهة علمانية- إسلامية، تنضاف للمسألة الكردية المشتعلة منذ 1984. لن يستطيع وقتها الإسلاميون ولا الطورانيون ولا الأتاتوركيون أن يكونوا إطاراً جامعاً لتركية التي يمكن أن تعيش وقتها انفجاراً داخلياً سيكون أقوى من الانفجارات التي شهدناها في سوريا وليبيا واليمن منذ عام2011 وما يمكن أن يحصل في تونس ما بعد 25 يوليو 2021 المرشحة لانفجار داخلي.
السؤال: هل يستطيع مشروع “الأمة الديمقراطية” أن يكون إطاراً مستقبلياً جامعاً للأتراك، أم لا؟.