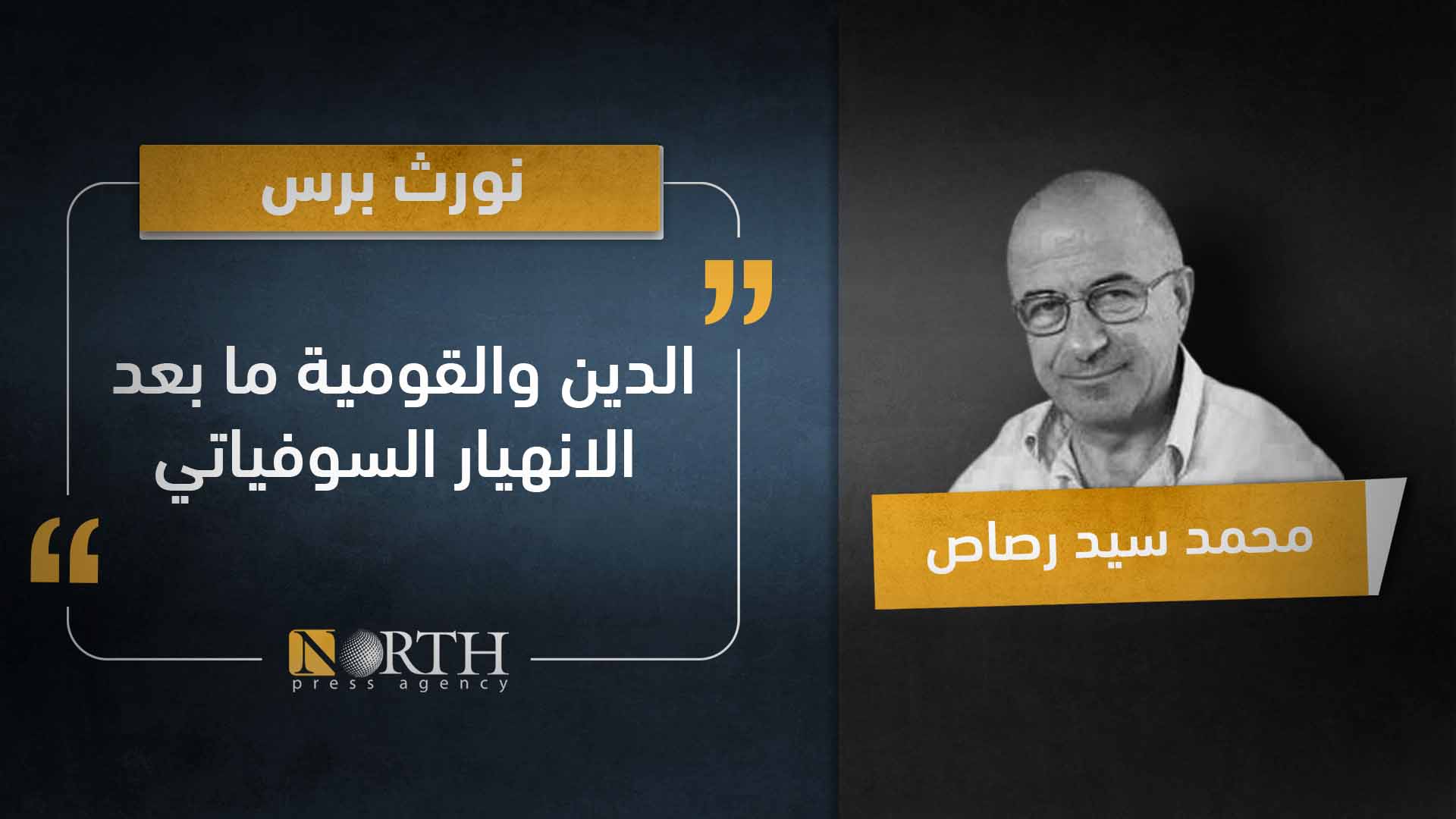لم تظهر في انكلترا القرن العشرين مشكلة أو حساسية بروتستانتية – كاثوليكية، وهذا كان دلالة على أن الانكليز قد تجاوزوا خلافاً رسم وحدد تاريخ انكلترا، من خلال فصل كنيسة انكلترا عن روما في عام 1534 ومن خلال ثورة 1688-1689 التي ثار فيها الانكليز على الأسرة المالكة التي أرادت اعتناق الكاثوليكية متأثرة بتجربة نفيها الباريسي بعد إعدام الملك تشارلز الأول عام 1649 ومن ثم عودتها للحكم عام 1660 مع عهد الإعادة، حيث كان واضحاً ميولها التابعة لفرنسة سياسياً وثقافياً إلى درجة أن أفراد الأسرة المالكة الانكليزية كانوا يخاطبون بعضهم بالفرنسية.
طبعاً كان هناك أسباب أعمق للثورة الانكليزية تتمثل في الميل المجتمعي الانكليزي، وخاصة عند البورجوازية الناشئة، نحو ملكية دستورية يحكم فيها البرلمان وليس الملك، وهو ما كان استمراراً لثورة 1642-1649 التي ثار فيها البرلمان ضد السلطة المطلقة للملك.
بدورها، أظهرت فرنسا القرن العشرين أنها تجاوزت الخلاف الكاثوليكي – البروتستانتي الذي دفع الملك لويس الرابع عشر في عام 1685 إلى تهجير البروتستانت (الهوغنوت) من فرنسا وحرق كنائسهم، مما دفع الهوغنوت، وكانوا بغالبيتهم صناعيين ورجال مال وتجارة، للهجرة إلى جنيف أو إلى انكلترا وبعضهم للعالم الجديد.
هنا، أظهرت التجربة السوفياتية العكس، حيث بعد ثلاثة أرباع القرن من الحكم الشيوعي مع شعارات إلحادية ومحاولات لإنشاء كيان سياسي سوفياتي متجاوز للقومية، فإن ما ظهر إثر انهيار الاتحاد السوفياتي وتفككه أواخر عام 1991 كان كاشفاً ومظهراً بأن الأرثوذكسية، كمؤسسة كنسية وكأفراد متدينين، مازالت بالغة القوة في روسيا وأوكرانية، كما أن اليهود السوفيات الذين هاجروا بفترة 1985-1991 قد أظهروا ميولاً صهيونية قوية، وهو ما ينطبق على من بقي حتى الآن في روسيا وأوكرانية، كما أن مسلمي الاتحاد الروسي، وخاصة عند الشيشان، قد أظهروا منذ التسعينيات ميولاً قوية نحو الوهابية والسلفية، فيما انتعش حزب التحرير الإسلامي في كازاكستان وأوزبكستان، فيما ظهرت قوة السلفية – الجهادية، وهي أيديولوجية تنظيم القاعدة، في طاجكستان وقرغيزيا.
على صعيد القومية، انفجرت مشكلات قومية بين الأرمن والأذربيجان حول السيطرة على إقليم ناغورنو قرة باخ، ومشكلة قومية بين الشيشان والروس، ومشكلة قومية في أوكرانية بين الأوكران والأقلية الروسية المدعومة من موسكو في الشرق الأوكراني، هذا غير الحساسية القومية – الدينية بين الأوكران الأرثوذكس وبين سكان الغرب الأوكراني من البولنديين الذين يعتنقون الكاثوليكية والذين يسكنون في مقاطعات كانت تابعة لبولندا قبل أن يقتطعها ستالين ويضمها للاتحاد السوفياتي إثر اتفاقه مع هتلر عام1939على تقسيم بولندا.
من الواضح عبر هذه الوقائع أن التجربة السوفياتية كانت فاشلة في مسألتي الدين والقومية. يمكن هنا للتجربة اليوغسلافية، التي أراد تيتو من خلالها محاكاة التجربة السوفياتية في دولة تضم فسيفساء من الأديان والقوميات مثل روسيا القيصرية وروسيا السوفياتية، أن تظهر فشلاً شبيهاً بالفشل السوفياتي، ولكن موت التجربة اليوغسلافية كان مؤلماً أكثر من التجربة السوفياتية ومصحوباً بدماء ومجازر وتهجير.
يمكن هنا أيضاً أن تكون التجربتان السوفياتية واليوغسلافية هما آخر مثالين على فشل الدول ذات التركيب الفسيفسائي القومي- الديني، مثل الدولة العثمانية التي انهارت عام 1918، والامبراطورية النمساوية- المجرية التي انهارت بدورها أيضاً عام1918 بعد أن كانت مسيطرة على أجزاء واسعة من البلقان وكان اغتيال قومي صربي لولي عهد النمسا سبباً مباشراً في اندلاع الحرب العالمية الأولى عام1914.
يمكن لباكستان، التي أقيمت عام 1947 على أساس ديني، أن توضح، من خلال انفصال البنغاليين في باكستان الشرقية عام 1971 ومن خلال المشكلات القومية في باكستان الحالية بين البنجابيين المهيمنين على الجيش والإدارة وبين أهل اقليمي السند وبلوشستان، كيف أن العامل القومي يكون مفجراً ومفككاً للرابطة الدينية، هذا غير المشكلة الشيعية – السنية التي تنفجر بين الحين والآخر في باكستان.
يمكن لإيران، وهي دولة فسيفسائية قومياً ودينياً، أن تقدم مثالاً شبيهاً بالمثال الباكستاني، حيث الفرس الشيعة المهيمنون كقومية يضطهدون العرب الشيعة في خوزستان (عربستان) والكرد السنة الذين يشعرون باضطهاد مزدوج قومي- ديني، وهو ما يشعر به البلوشي السني أيضاً، وبالتأكيد كذلك الأذربيجاني الشيعي يشعر بالاضطهاد والتمييز وهو الذي كان عام 1979 مع آية الله شريعتمداري من أوائل من تمردوا على حكم الخميني مع العرب والكرد.
ولكن، وكخلاصة، وبالقياس للتجربة السوفياتية، فإن تجارب شيوعية انفتحت على العاملين القومي والديني وقاد فيها الشيوعيون الكفاح الوطني للتحرر من الأجنبي، مثل التجربتين الصينية والفييتنامية، كانت ناجحة ومستمرة، وزاد نجاحهما من خلال قيادة الشيوعيين لعملية التحديث والنمو الاقتصادي.