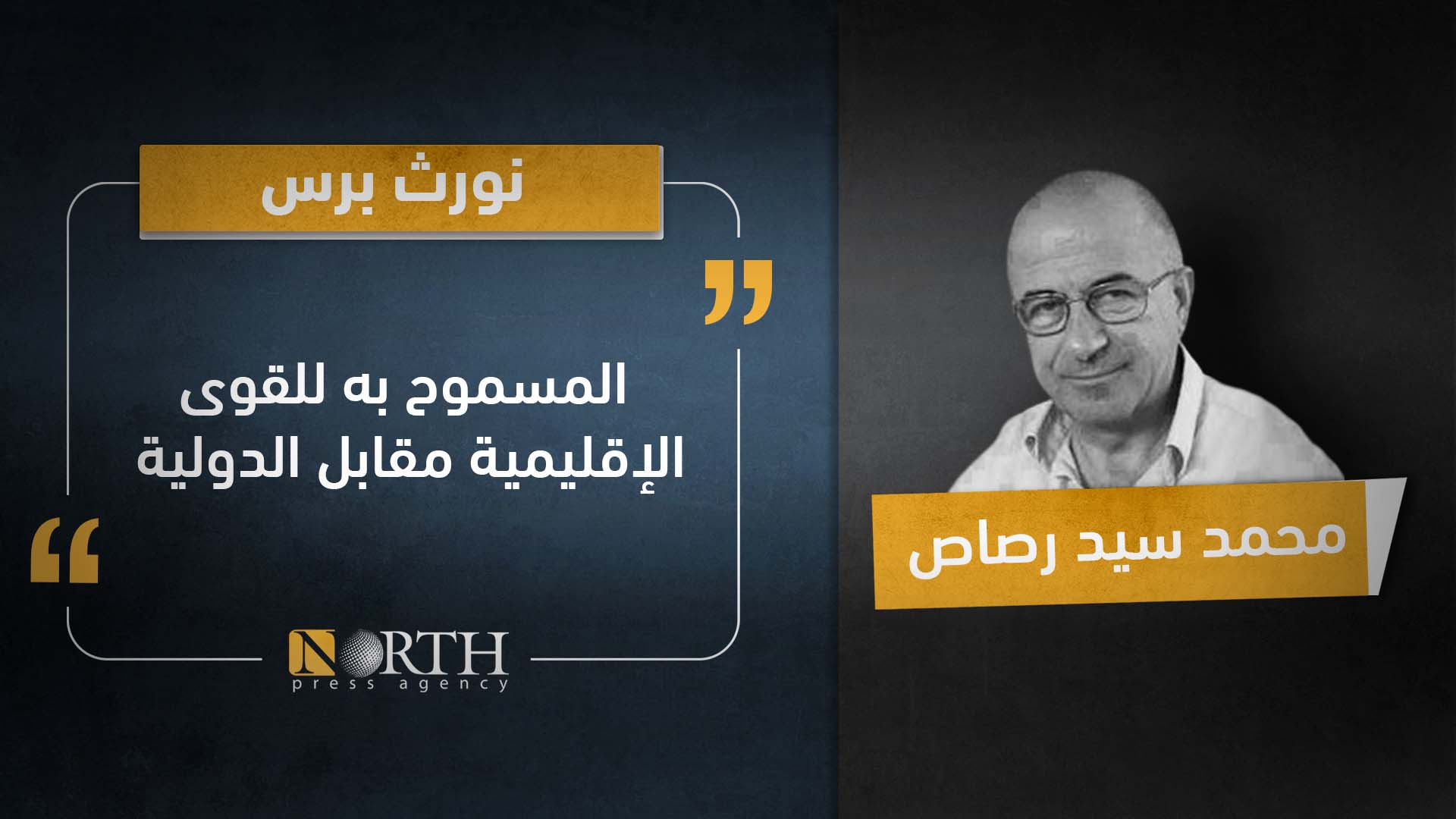يلفت النظر مدى التباعد بين إدارة بايدن وتل أبيب والرياض وأبوظبي فيما يخص موضوع الملف النووي الإيراني. يحصل هذا عند عواصم إقليمية وثيقة الصلة الشديدة بواشنطن، وهو ما يطرح ظاهرة تنفي أو تستبعد الهيمنة الأميركية المطلقة على تلك العواصم، ويصل ظن أو يقين البعض إلى وصم بعض تلك العواصم بـ”التبعية” و”العمالة” أو إلى الحديث عن “أميركية السياسة الإسرائيلية”.
في الحقيقة ما يحصل الآن مع جو بايدن قد سبق أن حصل من تلك العواصم الثلاث تجاه الموضوع نفسه عشية توقيع الولايات المتحدة وإيران ومعهما دول عديدة في إطار ما سمي بـ”اتفاق5+1″ على الاتفاق النووي الإيراني في في الرابع عشر من تموز/يوليو 2015، حيث ذهب بنيامين نتنياهو إلى واشنطن من أجل تحريض الكونغرس ضد الرئيس باراك أوباما الذي بدوره رفض استقباله في البيت الأبيض، فيما قامت الرياض وأبوظبي بشن حرب السادس والعشرين من آذار/ مارس 2015 ضد الحوثيين الذين كانوا قد سيطروا على صنعاء قبل ستة أشهر، وهي حرب لم يردها أوباما والذي رآها بوصفها جهداً من أجل تخريب الاتفاق النووي الإيراني الذي كان يومها قد وصل لمراحله الأخيرة، ولا يمكننا هنا أن نعزل التباعد بين الرياض وواشنطن عن عملية التقارب السعودي- التركي الذي حصل في ربيع وصيف 2015، وهو ما قاد إلى دعم كثيف للمعارضة السورية المسلحة والذي قاد بدوره إلى إسقاط المدن الثلاث الرئيسة في محافظة إدلب، أي إدلب وأريحا وجسر الشغور، ومعها قسم كبير من سهل الغاب، كما أن هذا الدعم السعودي-التركي هو الذي دفع زهران علوش، قائد ما يسمى بـ “جيش الاسلام”، إلى محاولة السيطرة على طريق دمشق- حمص في أيلول/ سبتمبر 2015، وهو ما هدد بحصار دمشق وربما أكثر، وهو ما دفع باراك أوباما إلى اعطاء الضوء الأخضر لفلاديمير بوتين من أجل التدخل العسكري الروسي في سوريا بدءاً من الثلاثين من أيلول/ سبتمبر 2015.
هنا، يقود هذا الفتق بين القوتين الإقليمية والدولية الحليفتين إلى أساليب ضغط، مثل التلويح السعودي بتقارب غير مسبوق في مجالات عدة مع موسكو عبر زيارة وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان لروسيا في حزيران/ يونيو 2015، حيث تم عقد اتفاقيات لبناء 16 مفاعلاً نووياً في السعودية من أجل الطاقة ومصادر المياه، إضافة لاتفاقيات اقتصادية كبيرة تفتح السوق السعودية أمام الروس. في هذا المجال لا يمكن عزل التقارب الإسرائيلي مع الروس والصينيين في السنوات العشر الأخيرة عن تقاربات واشنطن وطهران والتي توقفت في عهد دونالد ترامب ثم استؤنفت مع جو بايدن.
على هذا الصعيد، يمكن أن نرى مساعدة الإقليمي للدولي الحليف ضد “داخل الدولي المنافس”، بعد رتق الفتق بينهما كما جرى في عهد دونالد ترامب، وهو ما رأيناه في تطبيع الإمارات مع إسرائيل في الثالث عشر من آب/ أغسطس الماضي، حيث هدفت أبوظبي من هذه الخطوة إلى تعزيز فرص نجاح ترامب ضد بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية من خلال جذب أصوات اليهود الأميركيين للحزب الجمهوري، وفي الوقت نفسه أرادت أبوظبي منع وصول بايدن إلى البيت الأبيض وهو الذي كان قد أعلن منذ ربيع 2020 نيته العودة لاتفاق 2015 النووي مع إيران. يمكن هنا، أن تكون خطوة أبوظبي هذه، والتي دعمتها الرياض ضمناً، تهدف إلى تشكيل تحالف إقليمي- إقليمي من المتضررين من عودة محتملة لواشنطن لاتفاقها مع طهران، الذي انسحب ترامب عام 2018 منه، في حال فوز بايدن، وهو ما نراه الآن بين تل أبيب وأبوظبي، فيما يبدو أن الرياض قد اختارت طريقاً آخر وهو التفاهم مع طهران، أو تحاول منذ نيسان/ إبريل 2021 استكشافاً منفرداً لهذا الطريق، في سياسة مختلفة عن تلك التي انتهجتها عام 2015.
في هذا المجال، يمكن أن يكون لعب رجب طيب أردوغان بين واشنطن وموسكو منذ التاسع من آب/ أغسطس 2016 مثالاً نموذجياً على إمكانية امتلاك القوة الإقليمية لمساحة كبيرة من حرية الحركة تجاه قوة دولية أو أكثر. رأينا هذا عند جمال عبدالناصر عندما لعب بين موسكو وواشنطن بين عامي 1958 و1964، قبل أن تقرر واشنطن وضع بيضها في سلة تل أبيب، وهو ما جعله مضطراً لإيقاف تلك اللعبة المزدوجة والارتماء في حضن السوفيات، وعلى ما يبدو أن أردوغان سيجبر بدوره على الاختيار بين واشنطن وموسكو، وأحلاهما شديد المرارة عليه.
هنا، يجب التأكيد على أن ما شهدناه في 2015 بين واشنطن وتلك العواصم الثلاث، وهو ما يتكرر عام 2021 ولو بطريقة مخففة، له سوابق في العلاقات الدولية، مثل ما رأيناه بين الملك فيصل بن عبدالعزيز وإدارة نيكسون-كيسنجر في عامي 1974 و1975 من خلاف حول موضوع حل الصراع العربي-الاسرائيلي ورفض الملك السعودي للحلول الجزئية، وهو ما قاد ،على الأرجح، إلى اغتيال الملك فيصل في الخامس والعشرين من آذار/ مارس 1975 بسبب ذلك، ويجب أن يضاف إلى ذلك المساحة الكبيرة من حرية الحركة تجاه واشنطن التي أخذتها الرياض عبر حظر النفط عام 1973، وهو ما أصاب الاقتصاد الغربي الأميركي-الأوروبي بأضرار بالغة.
وفي هذا المجال، هناك تأويلات كثيرة لسقوط شاه إيران عام 1979 وعدم محاولة واشنطن إنقاذه من السقوط كما فعلت عام 1953 ضد حكومة محمد مصدق، تربط هذا السقوط بطموحات الشاه إلى بناء قوة إقليمية كبرى تأخذ مساحة حرية حركة كبرى تجاه واشنطن التي رعت في النصف الأول من السبعينيات مقولة أن طهران هي “شرطي الخليج”.
كتكثيف: يحاول هذا المقال المرور في حقل مليء بالأشواك والحفر، بعيداً عن الأهواء وعن التحليلات الرغبوية أو تلك التحليلات التي تحاول تقسيم العلاقات الدولية إلى معسكرات شديدة الإغلاق أو لا ممرات أو شقوق بينها.