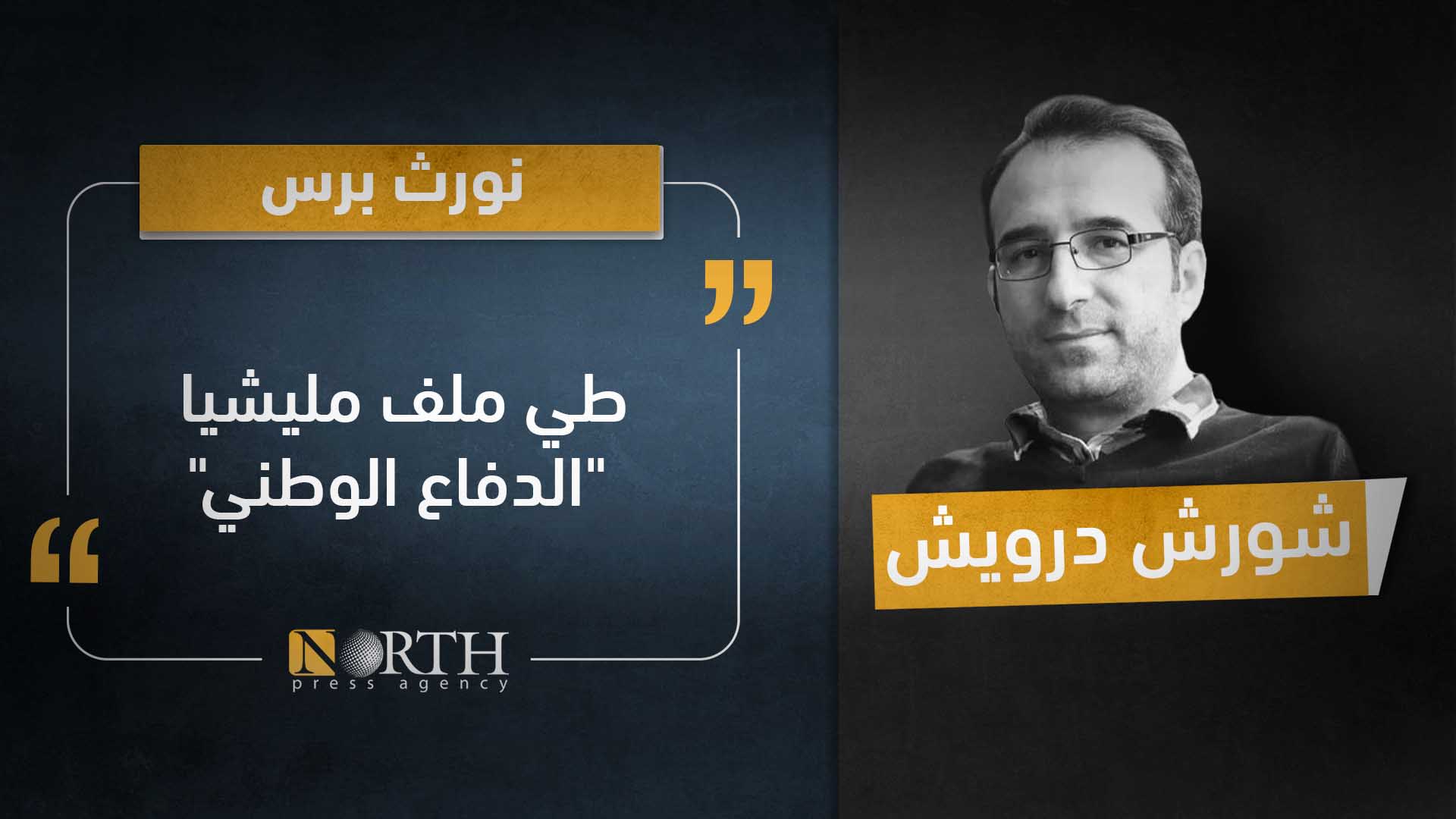بدت الأحداث التي جرت في القامشلي مؤخّراً في حاجة إلى شكل آخر من المقاربات، بعيداً عن أهواء الأطراف السياسيّة وتعجّلهم في إطلاق التوصيفات، أي بعيداً عن استلاف مقاربات سهلة من مثل اعتبار ما حصل “فتنة” أو “مؤامرة” أو ما شابه ذلك من تسميات تثير الحفيظة وتفتقر إلى التحليل المناسب للحدث؛ ذلك أن دقّة التمييز والتفريق بين الاشتباكات المسلّحة وبين الحرب الأهلية “الفتنة” أمر واجب وضروريّ في ظل الفوضى التي تحكم منطق كثير السوريين، فضلاً عن أن أي تحليل للحدث السريع ينبغي ألّا يرفعه إلى مصافي الحدث التاريخيّ، أو المعطوف على أحداث تاريخيّة سابقة.
في الأصل تشكّلت ميليشيا الدفاع الوطني بعد قليل من انحسار الوجود الأمني في محافظة الحسكة من قبل زبائن النظام السوري ومواليه، وهذه الميليشيا لم تسجّل أي عمل إيجابي في سجل الدفاع عن المنطقة، لا في مواجهة داعش ولا في مقاومة المسلّحين المدعومين من تركيا، وبالتالي انحسرت وظيفة هذه الجماعة المسلّحة في تكريس حضورها ضمن أحياء محددة داخل مدينتي القامشلي والحسكة.
يمثّل مبدأ “احتكار العنف” (حق استعمال القوّة)، بحسب ماكس فيبر، أفضل السبل للقول بوجوب وجود قوّة مسلحة وأمنيّة واحدة يكون لها الحق الحصري في استعمال العنف للتصدّي للمجرمين ومكافحة الإرهاب وبسط الأمان، وهذا الحق في العادة تختصّ فيه الدولة، إلّا أن الدولة السوريّة (النظام) انسحبت وماطلت في القيام بدورها، ولم تكن محايدة تجاه المواطنين بل غدت جزءاً من آلة القتل والعقاب والمساءلة دون أن تتحمّل مسؤولياتها في مواجهة الأخطار الداخلية كتنامي الإرهاب والذود عن الحدود والحفاظ على السيادة، وبالتالي أسقط النظام، بملء إرادته، من يديه مبدأ احتكار العنف، حيث أقام وأسس وساهم في نشوء ميليشيات من خارج قوس قواته المسلحة وجلب أخرى من خارج الحدود، مع أن الدولة يتوجّب عليها عدم السماح وحظر تأسيس الميليشيات حتى وإن كان قرارها بيد الدولة؛ فالدولة ليست مصنع ميليشيات في تعريف آخر.
شيء من مبدأ احتكار العنف تحقّق على يد الإدارة الذاتيّة، التي وقفت منذ بدايات انتشار الأعمال المسلحة في سوريا موقف الرافض لتعدد القوى المسلّحة في مناطق تواجدها، ووسّعت من التركيبة الإثنية لقواتها، والحديث الآن عن قوات مختلطة إثنياً لا تمثّل كرد سوريا وحسب لا سيّما في قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أو جهاز الأمن الداخلي (الأسايش)، وبالتالي أدى هذا التشكيل، متعدد الإثنيات، إلى طرد أشباح الفتنة واحتمالات احتساب أي عمل أمني أو عسكري على أنّه مشروع قوميّ يرمي إلى تسيّد قوميّة على بقية الشركاء.
لكن ما أثار الحفيظة خلال الأيام القليلة الماضية التي شهدت اشتباكات انتهت إلى هزيمة ميليشيا الدفاع الوطني المنحلّة، كان الاستعجال في تسمية الحدث بأنّه “فتنة”، رغم أن الفتنة تعني صداماً أخذ أو سيأخذ منحاه الإثنيّ/القومي، وهو يجافي طبيعة القوتين المتقاتلتين حيث أن تشكيلة “الدفاع الوطني” لم تكن ممثّلاً أو تعبيراً لجماعة أهليّة، إنّما كانت قوّة محلية ضمن عداد الميليشيات الموالية للنظام، فيما شكّلت قوات الأمن الداخلي عماد الجهاز الأمني في المدن والبلدات والقرى ضمن مناطق شمال وشرق سوريا، علاوةً عن أنّ نسبة المنخرطين في صفوفها من غير الكرد مرتفعة، الأمر الذي يجعل وقوع فتنة قومية أمراً بعيد المنال، يضاف إلى ذلك أن الفتنة قد تعني أن قوّتي الأسايش والدفاع الوطني كانا في خندق واحد، في حين أن كل الوقائع تؤكد على أنّ القوتين كانتا على طرفي نقيض ومتخاصمتين وسبق أن اشتبكتا في غير موقع، إذ لم يسبق أن كانت القوّتين في حالة وئام أو مؤتلفتين أو مشتركتين في جبهة واحدة.
تذهب ترجيحات إلى أن الدفاع الوطني كان يحظى بدعم إيرانيّ، وأن النظام فقد حماسته في تأمين مظلّة لهذه القوة التي باتت لزوم ما لا يلزم، يزيد من هذا الافتراض موافقة الروس السريعة على حلّ هذه القوات والنزول عند اشتراط الإدارة الذاتية بإنهاء أي دور للدفاع الوطني بخاصة في حي الطي.
وليست العملية الأمنية التي خيضت في حي الطي موجّهة إلى عشيرة أو تجمّع أهلي في مدينة متعددة القوميات والثقافات، كما أن العملية لم تكن معطوفةً على ماضِ قريب حيث يريد البعض تفسير الموضوع وفق سردية مغايرة للواقع وأن الذي حصل ما هو إلّا “قصاص” للانتفاضة الكردية عام 2004. مع أن مسار الأحداث لا يشير إلى رغبة في الانتقام أو تأديب متورطين في قمع الانتفاضة، ولم يحدث إلى اللحظة تعقّب أو مساءلة متورطين في تلك الأحداث منذ أن أعلن عن الإدارة الذاتية.
في مجمل الأحوال، حصّنت الإدارة الذاتيّة، بعد هذه العملية الأمنية السريعة، أحد خواصرها الرخوة، وبذلك تصبح القامشلي في موازاة قوّتين، بدل تعدد القوى، واحدة تمثّل الإدارة الذاتية وهي الأوسع نفوذاً وتأثيراً، وأخرى يمثّلها تواجد النظام وهو تواجد محدود الأثر والمساحة ويقترب لأن يكون رمزياً. ولعل المهمة التي تنتظر الإدارة في هذه الغضون تكمن في سعي مسؤولي الإدارة إلى تضمين حي الطي في الجهاز الإداري والأمني وتلبية متطلّبات السكان وتخليص بعضهم من مخاوفهم المتصلة بهزيمة وحلّ الدفاع الوطني.
ما حصل في حي الطي لم يكن حرباً كردية عربيّة وهذا ما بات مسلّماً به، ولا صراعاً بين الكرد والنظام بالمعنى الواسع للكلمة، ولا إعلان حرب على عشيرة، الأمر يمكن أن يفسّر على نحو أكثر وضوحاً وأشد بساطة: لا يمكن أن تتعايش قوّتان في مساحة ضيّقة، واحدة تريد أن تحوّل حيّها إلى معسكر مغلق يتبع قوانين خاصّة، وأخرى تسعى إلى تكريس نموذج إداري قابل للعيش والاستمرار، وعليه فإن الاشتباكات كانت لتقع لو توفّرت الظروف والمسبّبات ذاتها في مدينة أخرى أو في حيّ آخر يحمل اسماً كردياً أم عربياً.