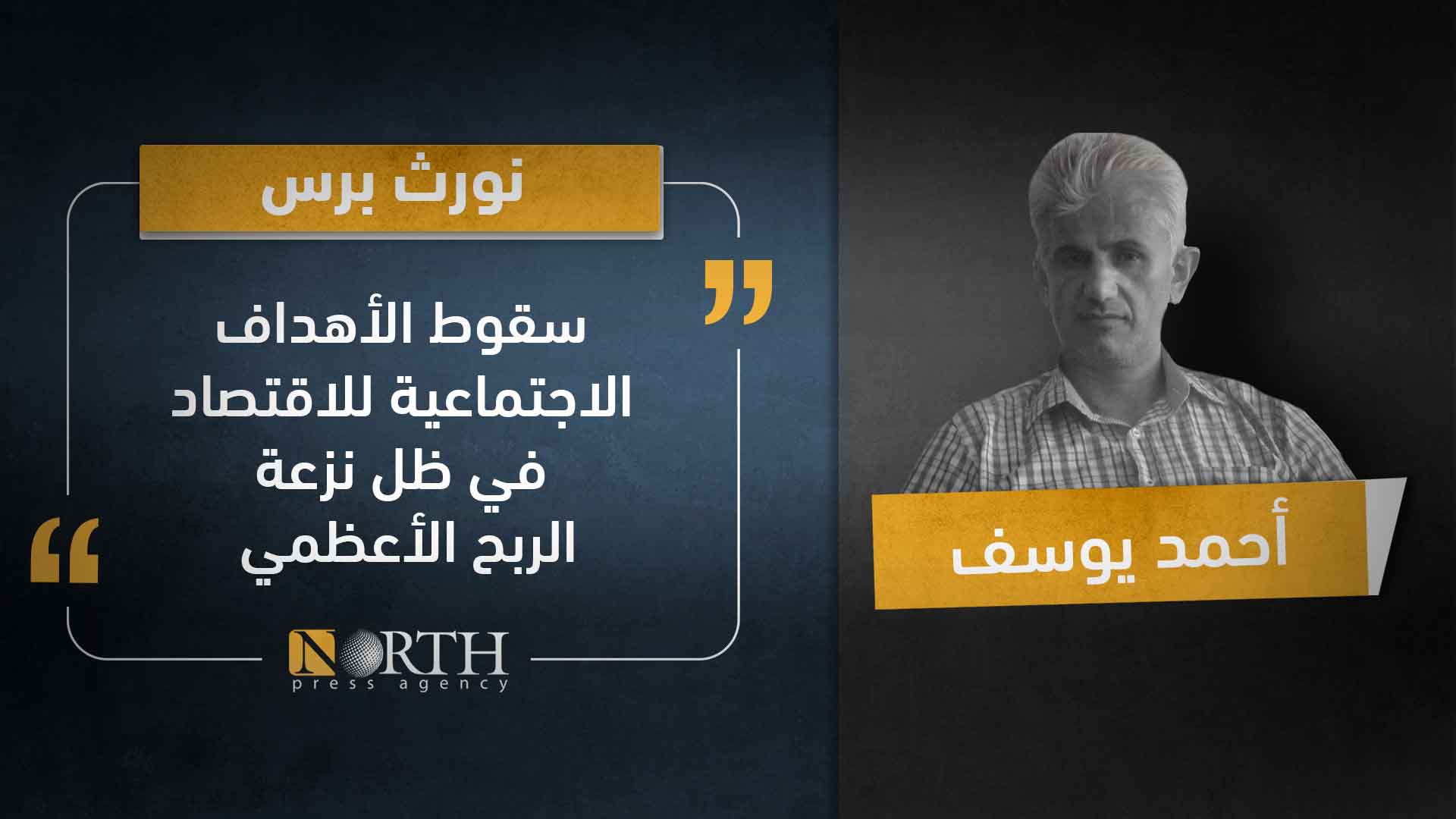يعد علم الاقتصاد واحداً من أهم وأكثر العلوم التي تعرضت للمناقشات واختلافات وجهات النظر في حيثياته. ويعود ذلك لطبيعته بالانتماء أولاً إلى قائمة العلوم ذات الصلة بالمجتمعات والعلاقات الاجتماعية بصورةٍ مباشرة، وثانياً باعتباره العلم المسؤول مباشرةً عن تفسير تكوين الثروات وتطوير العلاقات المالية والنقدية بين مختلف المؤسسات على الصعيد العالمي، حيث أن تلك العلاقات تنطبق على العلاقة بين الأفراد في أدنى سلم العلاقات المالية، وكذلك على العلاقات بين الدول، كما أنها تنطبق على المؤسسات والشركات المحلية والعابرة للقوميات.
وحاولت المدارس الاقتصادية الرأسمالية والاشتراكية على حدٍ سواء أن تؤكد صحة أطروحاتها التي تخدم مصالح الفئات التي تدعمها، إلا أنها لم تتمكن من إثبات صحة مواقفها، فالمدرسة الاقتصادية الكلاسيكية كانت تمتلك قدرةً براغماتية كبيرة لإثبات أن تحليلاتها الاقتصادية تشكل جوهر التطور على جميع الأصعدة، وتحاول من خلال تحليلاتها تلك تبرير السلوك الاستغلالي الذي يمارسه الرأسماليون في المجتمع الغربي، ولم تستطع المنظومة السياسية التي قامت بتطبيق أفكار هذه المدرسة من الحؤول دون السقوط في هاوية الأزمات المتكررة للرأسمالية، خاصة الأزمات الاقتصادية التي بدأت تشهدها الرأسمالية منذ عشرينيات القرن العشرين.
كما أن المدرسة الماركسية المناقضة في ظاهرها لجوهر الرأسمالية لم تستطع الخروج من بوتقة الدولة القومية الحامية للمنظومة الرأسمالية على الصعيد العالمي، وذلك دون أن يدرك الماركسيون حقيقة الخطأ الذي وقعوا فيه إلى وقت قريب.
الإنتاج لغاية خلق الحاجة
وبين هذا وذاك لم تتوقف عجلة تطور النظام الرأسمالي عن السير نحو بناء مفاهيم جديدة تخدم عملية السيطرة الكاملة للمنظومة عالمياً، فقد كسبت هذه المنظومة الصراع ما بينها والمنظومة الاشتراكية التي سادت في شرق أوروبا وبعضاً من الدول المتناثرة في القارات الأخرى. وتمكنت من ترسيخ قواعدها بأساليب مختلفة، تراوحت ما بين عملية الاستمرار في الإنتاج لخلق الحاجات وتحقيق المزيد من علاقات الارتباط والتبعية لها كمنظومة سياسية-اقتصادوية وما بين تطوير منظوماتها العسكرية ونشرها في مختلف بقاع الأرض.
واستطاعت المنظومة الرأسمالية تحقيق سطوتها في القرن العشرين على العالم، بالرغم من أزماتها المتكررة، عبر المساهمة الفعالة في إفشال المنظومة الاشتراكية، التي لم تكن قادرة على إغراء مواطني الدول التي تسيطر فيها على تقبل أفكارها الاقتصادية طواعية، فالقوة الأخرى المتمثلة بالرأسمالية كانت أكثر قدرة على تحقيق الجذب للمواطنين بمنح الأهمية الكبيرة للنمو الاقتصادي الذي أصبح حاجةً لا يمكن الاستغناء عنه، لضمان استمرار تدفق السلع والخدمات والأرباح، وبالتالي فقد خلق هذا النظام حالةً من المنافسة والتسابق الشديد بين المؤسسات الإنتاجية لتحقيق المعدلات العالية من النمو في إطار الأهداف العامة للدول لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفع، وتحقيق تطورات كبيرة في نمو الناتج القومي الإجمالي، وبات ذلك من أهم المؤشرات التي تستخدمها دول العالم وفي مقدمتها الدول الرأسمالية للدلالة على القوة الاقتصادية لها، إلا أن ذلك في حقيقة الأمر يشير إلى ما هو أعمق من ذلك، فالدلالة الأهم لهذا المؤشر هو تحديد مدى إمكانية كل دولة على منافسة دول الأخرى لبلوغ قمة هرم الأرباح المرتفعة الناجمة عن مختلف النشاطات التي تتم ممارستها تحت بند الممارسات الاقتصادية للبلد. ولا شك أن السعي لتحقيق هذا الهدف المنشود من قبل مختلف دول العالم أدت إلى إخراج الاقتصاد من حقيقته باعتباره العلم الذي يحقق احتياجات المجتمع، وتجاوزه لذلك إلى العلم الذي يحقق أعظم ربح ممكن للمستثمرين، وترك القضايا الاجتماعية والبيئية جانباً، وإن كان ذلك بصورةٍ غير واضحة.
الولع بالنمو ليس حلاً
يرى المؤرخ ج. آرماكنيل أن الولع بالنمو عمل على إحكام قبضته على التصورات والمؤسسات في القرن العشرين، وقد تحمل كل من الأندونيسيين واليابانيين فساداً لانهائياً على مدى حقبة النمو الاقتصادي. ولقد تحمل الروس وسكان أوروبا الشرقية الكثير من دول خرقاء قامت بفرض رقابةٍ سيئة عليهم، ولقد قبل الأمريكيون والبرازيليون التفاوت الاجتماعي الهائل، وذلك في غمرة النمو الاقتصادي.
إذن نرى أن المحاولات الحثيثة للقوى الرأسمالية الغربية لا تتوقف مطلقاً عند حدود تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان، والبقاء ضمن إطار الاقتصاد الطبيعي، بل يتعدى ذلك للانتقال إلى حالة تأمين جميع السبل والإمكانيات اللازمة لتسخير الموارد الاقتصادية بأقصى صورها لتحقيق الربح الأعظمي مستفيدةً في ذلك من منجزات الثورة العلمية- التكنولوجية التي باتت بدورها ثورة على تباطؤ النمو الاقتصادي وعدم قدرته على الاستجابة لتعطش النظام الرأسمالي للأرباح الهائلة. وقد بدأت ملامح هذه الثورة العلمية-التكنولوجية واضحة مع دخول المنظومة الرأسمالية مرحلة الرأسمالية الصناعية في القرن الثامن عشر، على الرغم من أن تطور مفهوم التفكير العلمي سبق ذلك في القرن الثالث عشر، وذلك عندما بدأ التنويريون بسحب البساط من تحت أقدام الكنيسة التي نصبت نفسها خليفة الله على الأرض وجعلت من نفسها مصدر كل القوى التحليلية قبل أن يتقلص دورها أمام القوة العلمية البارزة بفضل العلماء من مثل غاليلو غاليلي وبرونو اللذين واجها الموت دفاعاً عن أفكارهم المناقضة تماماً لأطروحات الكنيسة التي ما لبثت أن فقدت قوتها أمام تمدد الرؤى العلمية. ولم تنتهج منهجية مقاربة لسلوكيات الرأسمالية فحسب، بل أكثر من ذلك، فقد اصبحت تابعاً لآلة الإنتاج الرأسمالية وسبباً في تطوير تلك الآلة في الوقت ذاته، لتحقيق مزيد من الاستغلال والانتقال نحو الاحتكار في مختلف الصعد.
ويعتبر تأمين الاحتياجات للمجموعات السكانية على امتداد المعمورة ضرباً من السذاجة الاقتصادية لدى مختلف المدارس الاقتصادوية الرأسمالية، نظراً للخطورة الكامنة في هذا الأسلوب من التفكير الذي قد يؤدي إلى تصفية الجهة الساعية إلى دعم هذا الاتجاه من التفكير والتحليل، وذلك تحت تأثير قوة المنافسة من الجهات التي تسعى إلى تدعيم مواقفها بأساليب حسابية معقدة لاحتلال مراحل متقدمة في الإنتاج وتقديم الخدمات غير المجانية.
الربح الأعظمي يطلب إنجازات علمية مستمرة
ويتطلب تدعيم الأساليب المتطورة في تنمية طرق تحقيق الربح الأعظمي تسخير المؤسسات العلمية والكفاءة العاملة في تلك المؤسسات لإبداع الأفكار الجديدة لحماية الاحتكاريين في السوق. لذلك لا غرابة في أن تفتقر إلى الدراسات المتعلقة بالجوانب الاجتماعية وتحقيق عدالة التوزيع، لأن العدالة هي آخر المجالات التي تحظى باهتمام تلك المؤسسات. فالهدف الأساسي لها هو ترسيخ مفهوم النجاح المتعلق بتحقيق أعظم الأرباح.
لقد شكل هذا الأسلوب من التعامل والدراسات أهم خصائص النظام الرأسمالي في جميع مراحل تطوره، إلا أن ذلك لا يعني أنه تعرض أحياناً لبعض التقلص لصالح الاهتمامات الاجتماعية، خاصةً في الفترة التي تنافست فيها الرأسمالية مع النظام الاشتراكي الذي ساد دول أوروبا الشرقية لكسب الدعم الشعبي لمواقفها، الأمر الذي كان يجعل من النظام معتدلاً نسبياً في بعض أطروحاته الاقتصادية والاجتماعية. لكن انهيار المنظومة الاشتراكية فُسِّرَ لدى البعض من مفكري الرأسمالية على أنه نهاية التاريخ (فرانسيس فوكوياما)، أي نهاية عصر الاهتمامات الاجتماعية في الطروحات الاقتصادية، التي باتت بمعظمها أطروحات داعمة لسياسات تعظيم الأرباح. وقد انحازت جميع المدارس الرأسمالية إلى منح الأولوية المطلقة لكيفية التسابق على تحقيق الربح الأعظمي بتسخير السياسات التي أدت إلى تطوير مؤسسات من شأنها التوجه نحو التركز والتمركز في سيطرة القوى الأكثر قدرةً على البقاء في ظل المنافسة الشديدة، ويرى عادل المهدي أن أهم تلك السياسات هي:
- التطور التكنولوجي الذي يؤدي إلى تقليص حجم المصاريف الجارية للشركات.
- الاندماج بين الشركاء لبناء شركات عملاقة قادرة على ابتلاع منافساتها، وأصبح هذا التوجه حالةً مميزة في المنظومة الرأسمالية مع بداية القرن الحادي والعشرين.
- الاستمرار في تكوين التكتلات الاقتصادية بين القوى التي تمتلك تقارباً سياسياً وإيديولوجياً.
- اندماج أسواق المال الدولية التي أدت إلى تجاوز الحدود السياسية للدول والاتجاه نحو إزالة القيود التشريعية والتنظيمية والرقابية على المعاملات المالية بالأسواق الدولية، كل ذلك لصالح نمو الشركات وتضخم حجمها لتحقيق المزيد من الأرباح.
ومما لاشك فيه أن العوامل المذكورة أعلاه أدت إلى ارتفاع متوسط دخل الفرد عالمياً، ما يعني زيادة الأرباح الناجمة عنها. لكن الملاحظ بشكل واضح هو أن تلك الزيادة في متوسط الدخل لم تكن لمصلحة الفقراء، وإنما كانت لخدمة الشركات والمؤسسات العالمية الهادفة إلى تحقيق المزيد من السيطرة على جميع مفاصل الحياة.
وتظهر هذه النتيجة بصورةٍ واضحة من خلال دراسةٍ، أجراها صندوق النقد الدولي عن اتجاهات توزيع الدخل خلال القرن العشرين عن 42 دولة يمثل عدد سكانها أكثر من 90% من إجمالي عدد سكان العالم، تبين أن متوسط دخل الفرد قد ارتفع بصورةٍ ملحوظة في هذه المجموعة من الدول، غير أن توزيع هذه الزيادة في الدخل بين هذه الدول لم يكن بصورةٍ متساوية، وساء التوزيع في نهاية القرن مقارنة ببداية القرن.
الربح الأعظمي مناقض للأهداف الاجتماعية
إن ما سبق يوضح لنا أن المنظومة الرأسمالية تستهدف الربح الأعظمي إلى جانب استبعاد الأهداف الاجتماعية للنمو الاقتصادي، على الرغم من توسع دائرة عمل المنظمات والمؤسسات الداعمة لتوسيع أثر النمو الاقتصادي بحيث يشمل تنمية الجوانب الاجتماعية من أجل تقليص الفوارق الدخلية بين مختلف مكونات المجتمع، إلا أن الإحصاءات تشير إلى عدم فاعلية تلك المنظمات والمؤسسات أمام القوة الهائلة للمؤسسات الربحية التي نجحت في توظيف معظم الإمكانات العلمية والبشرية والطبيعية لصالح آلة إنتاجها. واستناداً إلى معرفة هذه الحقيقة السوداوية التي سادت وتطورت في القرن العشرين وما زالت قيد التطور وبوتيرة أعلى من القرن الحالي. يمكننا الحكم على الزيادة العددية للمنظمات والمؤسسات ذات الطبيعة الاجتماعية على أنها جزء من ردة فعل مرنة تجاه سطوة المؤسسات الربحية، لذلك فهي لن تكون قادرة على قلب موازين القوى لصالح العدالة الاجتماعية في مجتمع بات كل شيء فيه ذا قيمة مادية، وأصبح التقييم المادي هو المعيار الأساسي في جميع المفاصل الاقتصادية والاجتماعية.