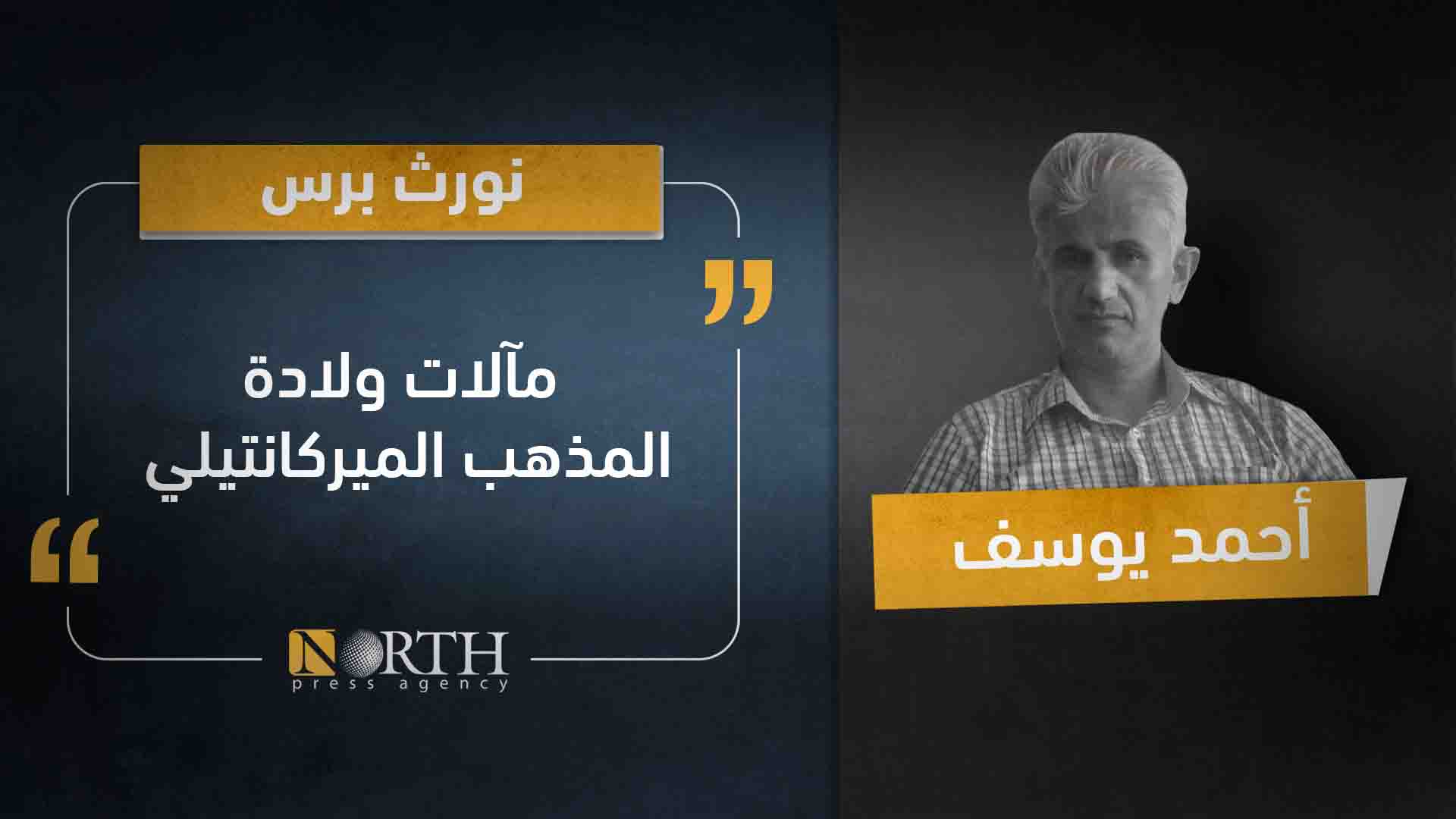هل نستطيع استخلاص الدروس منها؟
لقد أدت حركة الكشوف الجغرافية الأوروبية في نهاية القرن الخامس عشر إلى تطوير النزعة الاستغلالية للأوروبيين وعمقت من مستوى العلاقات ما بين حكوماتها والرأسماليين الصناعيين والتجاريين، ولما رأت الرأسمالية الأوروبية الناشئة أنها بحاجة إلى منهجية محددة لحماية سلوكياتها الخارجة عن إطار العلاقات الإنسانية بعد تجاوزها لمشكلات تحقيق التوازن ما بين الحاجات والموارد الطبيعية، بدأت المذاهب الاقتصادية بالتأثير على تنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على مستوى الدول الأوروبية وخاصةً الرائدة منها في مجال عالم البحار، وكان المذهب الميركانتيلي في مقدمة تلك المذاهب التي أثرت بقوة على الجوانب المختلفة للحياة، على الرغم من أنه لم يكن نتيجة بناء فكري متماسك، وإنما ولد هذا المذهب نتيجة تحالفات مصلحية ما بين التجار ورجال السياسة والمال.
لم تكن الميركانتيلية في جوهرها نظاماً فكرياً، وإنما كانت في المقام الأول نتاج عقول رجال الدولة وكبار الموظفين ورجال المال والأعمال في تلك الأيام. فكان الهدف الرئيسي لهذا المذهب هو تجميع أكبر كمية ممكنة من المعادن الثمينة في دولها انطلاقاً من قناعة روادها بأن هذه المعادن هي عماد الثروة لأي مجتمع من المجتمعات. لذلك طالبوا بأن يكون الميزان التجاري للدول التي طبقت هذا المذهب رابحاً بصورةٍ دائمة عبر تعظيم حجم النشاطات التصديرية مقابل تخفيض المستوردات إلى الحدود الدنيا الممكنة.
وبدأت تتوثق العلاقة ما بين السياسة والاقتصاد، أي ما بين الدولة والرأسماليين بوصفهما طرفين متكاملين في الاحتكار والنهب، مع صعود دور الميركانتيلية، وقامت الأخيرة بأطروحتها لتوثيق العلاقة المذكورة بإنشاء أول ظاهرة استغلالية خطيرة تتمثل في الدولة القومية التي امتد تأسيسها لغاية القرن العشرين ومازلنا نعيشها بكل عيوبها وثغراتها ونتائجها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكارثية وخاصةً في الدول المتخلفة، هذه الدول الناتجة بشكلها الراهن عن تعميق درجات التمايز بين المركز الرأسمالي والأطراف المنتشرة في القارات الثلاث(آسيا، أفريقيا، أمريكا). وقد تم دعم هذه العلاقة الوثيقة من خلال الاهتمام بتشكيل القوى العسكرية للحفاظ على مكتسبات الدولة القومية المتشكلة حديثاً بفضل أفكار المذهب الميركانتيلي وكذلك من أجل إحداث توسعات جديدة في المناطق الجغرافية التي تدخل تحت سيطرة الدول التي تطبق هذا المذهب، وبالتالي تعزيز تبعية الدول الأطراف لسطوة الاستغلال الرأسمالي الأوروبي عبر الأسلوب الكولونيالي للسيطرة.
لقد جردت الميركانتيلية نفسها من الجوانب الإنسانية في العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث أنها كانت تنطوي على اختلاف ملحوظ مع المواقف والوصايا الأخلاقية لأرسطو والقديس توما الأكويني والعصور القديمة بوجه عام. وبما أن التجار كانوا يسعون إلى الثروة في مجتمع هم فيه أصحاب نفوذ، وربما سائدون، فإن هذا المسعى فقد دلالته الشريرة أو المشكوك فيها. وقد ارتاح ضميرهم في هذا العصر.
ونظراً لأن الميركانتيلية استدعت تأمين قوة عسكرية مميزة لتحقيق أهداف الدول التي تطبقها، فإن تلك الدول قد تعرضت لمشاكل ناجمة عن عدم قدرتها على تشكيل تلك القوة العسكرية بسبب عوامل عديدة، كما كان عليه حال البرتغال، التي هي أول دولةٍ قومية أوروبية تتوسع سطوتها الخارجية باتجاه إفريقيا وآسيا نتيجة تطورها في عالم البحار وشجعت رأسماليتها المتشكلة حديثاً لتحقيق المزيد من الاستغلال بمساعدة القوى العسكرية فيها. فقد بدأت تنهار تحت وطأة ضآلة عدد السكان واعتمادها على الرقيق في معاركها وسقوطها بيد الإسبان في عام 1590م، وبدء تسرب الذهب منها بعد تزايد طلبهم على استيراد السلع الكمالية والمصنعة من الدول الأوروبية الأخرى.
ولم تكن الميركانتيلية الإسبانية في وضع يختلف كثيراً عن البرتغالية من حيث سياساتها النهبوية الممارسة مع الأطراف، حيث أقدمت إسبانيا من خلال تبنيها لمفهوم الميركانتيلية النقدية على تجميع الذهب والفضة بكميات كبيرة من خلال أكبر عمليات النهب في التاريخ لغاية ذلك الوقت من الأمريكيتين الوسطى والجنوبية ومنع إخراجها خارج حدودها القومية، وقد ترافق مع هذه السياسة الإسبانية الجديدة والمغرية من حيث الشكل تراجع هائل في الاقتصاد الطبيعي المعتمد على الزراعة وتأمين حاجيات السكان من الموارد المحلية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وحدوث التضخم بمعدلات مرتفعة جداً وخروج رؤوس الأموال البشرية المميزة باتجاه المناطق المكتشفة لما تحتويه تلك المناطق من مزايا تستقطب الشرائح الاجتماعية الغنية والمتطورة. وكذلك بدأ الذهب بالتدفق نحو الخارج كنتيجة طبيعية لتكوين الثروات وتزايد ميول الإسبان نحو المزيد من الإنفاق الكمالي المعتمد بشكل أساسي على الأسواق الخارجية. لم تتمكن هذه الميركانتيلية. شأنها شأن سابقتها البرتغالية، من الصمود أمام المنافسة الخارجية وخاصةً الهولندية والفرنسية والبريطانية، وكذلك الثورات المندلعة في الدول المستعمرة من قبلها، ما أدى إلى تراجع تدفق المعادن الثمينة إليها نتيجة تراجع قدرتها العسكرية أمام موجة المنافسة وتراجع القطاعات الاقتصادية الإنتاجية فيها، لا سيما القطاع الزراعي.
حينما تظهر علاقات أكثر قوة بين الرأسمال والسلطة، تبدو نتائجها أكثر تأثيراً على الواقع، فالميركانتيليتين البرتغالية والإسبانية فقدتا مكانتهما وقدرتهما الاحتكارية نتيجة ظهور احتكارات أكثر قوة ناجمة عن وحدة الهدف ما بين الرأسمالية التجارية ذات الأطماع التوسعية ورأسمالية الدولة الاحتكارية التي تلتقي مع الأولى بالهدف نفسه. نرى بأن الميركانتيلية الهولندية تمنحنا خير مثال عن هذه الحقيقة فمن جهة تقوم رأسماليتها بالنهب بأسطولها البحري المكون من حوالي 16 ألف سفينة يعمل عليها 163 ألف بحار ويجوبون سواحل العالم، ومن جهة أخرى تقوم حكومتها بتأسيس بنك أمستردام لتحتكر أعمال الصرف الأجنبي وتسوية المعاملات الخارجية، ولتحقيق المزيد من أعمالها التجارية والنهبوية تتأسس شركة الهند الشرقية، وكذلك شركة الهند الغربية بامتيازات خاصة من الحكومات الهولندية والبريطانية لزيادة السطوة الأوروبية على الدول الأطراف.
وعلى الرغم من أن الميركانتيلية الهولندية كانت أكثر إدراكاً من سابقتيها البرتغالية والإسبانية، وقامت لذلك بتحقيق نوع من التساهل على صعيد التجارة الخارجية، حيث أنها سمحت بالاستيراد من الخارج إذا كانت تلك المستوردات تخدم عملية تطوير القطاع الصناعي فيها، فلم تنج هذه الميركانتيلية أيضاً من التراجع والاضمحلال أمام نفوذ القوتين الفرنسية والبريطانية، ويلعب انخفاض عدد سكانها دوراً أساسياً في مآل الوضع بها إلى التراجع والانهيار.
وكانت الأوضاع الفرنسية شبيهة بالهولندية من حيث توجهها الفكري الداعم للصناعة المحلية من أجل تأمين احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية إضافةً إلى استغلال المستعمرات عبر نفوذها العسكري والتجاري، كما أن وضع أسطولها البحري كان قوياً نسبياً، وما ساعد على تطوير هذه الميركانتيليات السابقة، وكذلك نشاطها الممنهج لتجارة العبيد وتصدير منتجاتها بأسعار بخسة جداً ولولا حربها مع بريطانيا في حرب السنوات السبع لحافظت فرنسا على معظم مناطق نفوذها التي ساهمت في تفوقها الاقتصادي والسياسي بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى باستثناء بريطانيا التي تأخرت في الدخول إلى عالم البحار، وبالتالي عالم الاستعمار، إلا أنها ظلت الأقوى من بين الدول التي استخدمت النفوذ العسكري لتحقيق سيطرتها التجارية والصناعية خارج القارة الأوروبية عبر سياسات دعم المنتجات التصديرية بتغيير منهجية العمل الاقتصادي المعتمد في بريطانيا قبل ظهور أفكار المذهب الميركانتيلي وتطبيقها، ولم يكن تأسيس شركة إدوارد لويد للتأمين البحري وبنك إنكلترا في عام 1694م إلا لتحقيق المزيد من الاستقرار المالي وازدهار التجارة الخارجية، وتمويل حرب إنكلترا مع فرنسا، واكتسبت المؤسسات التأمينية البريطانية من حينه ولغاية يومنا هذا شهرةً عالمية متميزة، وساهمت من خلال سمعتها الواسعة الانتشار في تشجيع الشركات البريطانية بالتوسع والانتشار نحو مختلف أصقاع الأرض، وأدت إلى حماية المصالح الاحتكارية للرأسمالية البريطانية.
تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي كانت الرأسمالية الأوروبية تشهد توسعاً عالمياً عبر اكتشافها لطرق المواصلات البحرية الجديدة، كان نجم الشرق الأوسط قد بدأ بالأفول نتيجة خسارته لموقعه الاستراتيجي في التجارة العالمية وخاصةً تجارة طريق الحرير. وكذلك نتيجة انتشار ظاهرة الفساد السياسي وخاصةً في العهود الأخيرة من الدولة العباسية وولادة الإمبراطورية العثمانية الإقطاعية المعتمدة على أسواق الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية اعتماداً على نفوذها العسكري الواسع، ولم تتمكن من الصمود أمام المد الغربي نحو الشرق الأوسط لاستغلالها نتيجة عوامل عديدة، وتأتي في مقدمتها عدم قدرتها للدخول إلى عصر الصناعة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي التي سيطرت عليها على مدى القرون الأربعة الممتدة من القرن الخامس عشر، وكذلك غياب التوافق بينها وبين الشعوب التي سيطرت عليها، ما أدى إلى أن تثور تلك الشعوب ضدها وتحد من دورها، فاتحةً بذلك الأبواب مفتوحةً أمام الولوج الغربي نحو المنطقة بما يحمله من الأفكار التي تخدم إدامة سيطرته وتحقيق التشرذم في المنطقة من خلال تأجيج نار الانتماء القومي عبر تمجيد الماضي لكل قومية وترك الحاضر أسيراً للقوى الناهبة.
ولم تكن الميركانتيلية مذهباً فكرياً متكاملاً، إلا أن تأثيرها تجاوز حدود القارة العجوز وشكلت مرحلةً تاريخية مفصلية في مسار التطور البشري، من خلال نتائجها على الصعيدين الداخلي في الدول التي قامت باعتمادها، والخارجي المتأثر بمخرجاتها، ولا شك أن دراستها بمآلاتها المختلفة تضعنا أمام مجموعة هائلة من الاستنتاجات الهامة والضرورية للمساعدة في تجاوز عنق الزجاجة في المرحلة الراهنة، وفي ظل خضم الصراع المتعدد الأطراف والأهداف في الجغرافية التي وُلِدَ فيها ما سمي بالربيع العربي، فهل من قارئ ومُستَنْتِجٍ لمآلات ولادة مذهب التوسع جغرافياً والتركز مالياً؟